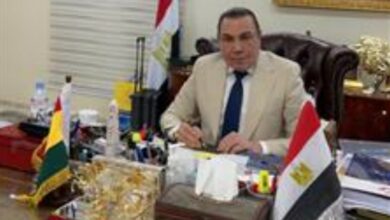تعرف الجريمة بأنها فعل أو إمتناع عن الفعل، و يقرر له المجتمع عقوبة. و تعرف العقوبة بأنها جزاء يوقع بإسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
وفي العصور القديمة كان الفرد يأخذ حقه بيده ، وتعينه على ذلك قبيلته أو عشيرته، وكانت تنشأ الحروب بين القبائل لأتفه الجرائم، ولم يكن للانتقام حدود، حيث كانت الغلبة للقوة. وقد تنوعت أصناف العقوبات في المجتمعات حسب طبيعة الجرائم و خطورتها، ففي الجرائم البسيطة كان العقاب يتمثل في السخرية والتهكم. أما إذا كانت الجريمة تكتسي صبغة خطيرة فالعقاب على ذلك الفعل يكون قاسيا ذو صبغة انتقامية، ذلك أن المذنب كان يكبل في عجلات من حديد، و يكلف بأعمال شاقة، وحمل الأحجار و تكسير الصخور، كذلك طمس الأعين وقطع الأنف، كذلك عقوبة تقطيع الأطراف الأربعة و حرق اللسان بحديد ساخن … وتترجم هذه القسوة في العقوبة في كونها وسيلة للانتقام من الجاني الذي اعتدى على غيره. و لقد أدى التطور الذي لحق بوظيفة العقوبة، من وظيفة الردع إلى وظيفة إعادة الإدماج في المجتمع، إلى ثورة قانونية وفلسفية وحقوقية في القرن الثامن عشر، توجت بمبدأ تفريد العقاب . ويراد بتفريد العقوبة جعل العقوبة ملائمة لظروف المجرم الشخصية المتمثلة في تكوينه الجسمي والنفسي والاجتماعي، وحالته قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجريمة، وظروف وطريقة ارتكابه الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها، والأضرار التي أصابت المجني عليه أو المجتمع من جراء الجريمة المرتكبة، والباعث على ارتكاب الجريمة…، و إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة لاختيار العقوبة المناسبة في نوعها ومقدارها للحالة الماثلة أمامه، و إخضاعه لما يلائمه من تدابير وقائية وعلاجية وتربوية تضمن تهذيبه وتربيته، والغرض منها جعل العقوبة أكثر ملائمة لشخصية المجرم، فالعقاب لا يكون عاما موحدا بالنسبة إلى كل من اقترفوا جرماً واحداً، ولكن يختلف من فرد لآخر وفقاً للاختلافات في الشخصية والدوافع وسائر الظروف التي تدفع إلى الجريمة داخلية أو خارجية وما إلى ذلك من الفروق الفردية بين البشر. و بمعني آخر التفريد في العقوبة يعني أن تتناسب هذه الأخيرة مع الجريمة والظروف والملابسات التي أحاطت بها وكذلك مع شخصية الجاني ومدى خطورته وظروفه الشخصية والاجتماعية والتي تختلف من شخص إلى آخر. و صنف التفريد الجزائي إلى ثلاثة أنواع يكمّل كل منها الآخر، وهي : – التفريد التشريعي أو القانوني: يكون التفريد تشريعياً حين يراعي المشرع في إنشاءه للعقوبة تدريجها بحسب ظروف كل مجرم، فيفرض على القاضي تطبيق نص معين عقوبته أشد أو أخف من العقوبة العادية المقررة لنفس الفعل إذا وقع في ظروف معينة أو من جناه محددين. و من مظاهر التفريد التشريعى للعقوبة:
- أن يحدد للجريمة عقوبة ذات حد ادني معين وحد أقصى محدد.
- يلتزم القاضي بعدم الخروج عنها في التطبيق العملي للعقوبة.
- عندما يوجب القانون تشديد العقوبة على الجاني في بعض الحالات كما في حال توافر الظروف المادية أو الشخصية المشددة.
- تبنى المشرع نظام الأعذار القانونية المخففة للعقاب سواء كانت أعذار عامة أو أعذار خاصة.
- المعاملة الخاصة للأطفال الجانحين، إذ ينص الفصل 45 م ج” يقع تطبيق القانون الجزائي على المتهمين الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة. لكن إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام. وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة تحط مدته إلى النصف على أن لا يتجاوز العقاب المحكوم به الخمسة أعوام. ولا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 م ج وكذلك قواعد العود”.
- التفريد القضائي: وهو الذي يتولاه القاضي بإختيار العقوبة المناسبة للجاني وتطبيقها عليه في حدود السلطات أو الصلاحيات التي يعترف بها المشرع للقاضي في هذا المجال. ومن صور التفريد القضائي أن يترك المشرع للقاضي سلطة اختيار القدر الملائم من العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، كالاختيار بين الإعدام والسجن مدى الحياة آو لمدة معينة في الجنايات، أو بين السجن و الخطية في الجنح؛ أو إمكانية النزول بالعقاب درجة أو درجتين وفقا لما تقتضيه ظروف الجريمة، و تطبيق العقوبات البديلة، و أيضاً الحكم بالعقوبة مع تأجيل تنفيذها… – التفريد التنفيذي: يتحقق هذا النوع من التفريد إذا خولت لسلطة التنفيذ الوسائل التي تتمكن بها من جعل كيفية تنفيذ العقوبة ملائمة لظروف كل محكوم عليه، فيسمح لها بتصنيف المحكوم عليهم، وإخضاع كل طائفة لإجراءات تنفيذ تصلح أفرادها، وأعطيت حق العفو العفو الخاص{ لرئيس الجمهورية حق منح العفو الخاص لفائدة المحكوم عليهم. و يؤدي العفو الخاص لفائدة المحكوم عليه إما لإطلاق سراح المعني بالأمر، أو التخفيض من عقوبته، أو إبدالها العقوبة بأخرى أخف منها} و السراح الشرطي { لا يُمنح إلا بشروط منها أن يكون المعني بالأمر حسن السيرة في السجن أو إذا ظهر إطلاق سراحه مفيدًا للمجتمع، وأن يقضي المحكوم عليه جزءًا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي نصف مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليه أول مرة على أن لا تصل مدة العقوبة المقضاة 3 أشهر، أو ثلثي مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية على أن لا تصل مدة العقاب المقضاة 6 أشهر}. إن مبدأ تفريد العقوبة يقتضي من القاضي ممارسة سلطته التقديرية في ذلك بمقتضى الآليات التي منحها إياه المشرع. إن الوضع المتعلق بجائحة كورونا، و ما ترتب عنها من جرائم تتعلق بحظر التجول و مخالفة قانون الطوارئ و الحظر الصحي الشامل و التسبب عمدا في نقل عدوى الفيروس إلى الغير و القتل العمد بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا و جرائم الاحتكار، يستدعي من القاضي تفعيل آلية تفريد العقوبة و الملائمة بين طبيعة هذه الجرائم و ظروف ارتكابها و الظروف الشخصية لكل متهم، و خطورة بعض هذه الجرائم، و جدوى العقاب و ذلك لتحقيق التوازن بين الغاية الإصلاحية و أنسنة العقاب من جهة و تحقيق الردع في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى الحد من انتشار عدوى هذا الوباء و من الممارسات الاحتكارية من جهة أخرى. و لعل ما أثارته الأحكام الصادرة في الأيام الأخيرة من ردود أفعال مختلفة، تدفع إلى تناول مسألة تفريد العقاب و دور القضاء في تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الردع و تحقيق الإحاطة و الإصلاح للمجرم. فما هي الأسس التي يقوم عليها مبدأ تفريد العقاب { الجزء الأول} و دور القاضي في ذلك { الجزء الثاني} الجزء الأول: أسس مبدأ تفريد العقاب يجد مبدأ تفريد العقاب أسسه في المدارس الجنائية الوضعية { الفقرة الأولى} و كذلك في الشريعة الإسلامية { الفقرة الثانية} الفقرة الأولى: تفريد العقاب في المدارس الجنائية الوضعية 1- المدرسة التقليدية: تميز النظام الجنائي في العالم الغربي في القرن 18 بالقسوة والحكم المطلق والتعسف الذي لا مبرر له، بحيث كانت للقضاة سلطة لا ضوابط لها تطغى عليها رغباتهم وأهوائهم، وكانت المساواة بين المواطنين مفقودة والتناسب بين شدة العقوبة وجسامة الجرم معدومة. و قد ظهرت المدرسة التقليدية للحد من هذا التعسف، و مؤسسها هو “بكاريا”صاحب كتاب “في الجرائم والعقوبات”، ونادي بالحيلولة دون تحكم القضاة وتعسفهم عن طريق سلبهم سلطة فرض العقوبات وطالب بإسنادها إلى جهات تشريعية. وقد كان للأفكار التي أتت بها المدرسة التقليدية أثر بالغ في ظهور مبادئ ومطالب إصلاحية في منظومة السياسة الجنائية تمثلت في الكف عن وحشية العقاب الذي ينافي إنسانية الإنسان، وجعل المسؤولية الجنائية شخصية ومبنية على حرية الاختيار، وظهور مبدأ عرف له مكانة دولية ألا وهو مبدأ الشرعية من أجل الحد من سلطة القضاء المطلقة، وجعل العقوبة متناسبة مع الضرر الذي أحدثته الجريمة حتى يتحقق أهدافها المتمثلة في تحقيق الردع العام والخاص. و ظهرت مدرسة تقليدية جديدة أقرت بمبدأ تفاوت المسؤولية الجنائية، و الذي ينتج عنه تفاوت العقوبات من حيث الشدة والتخفيف لتحقيق دواعي الأمن والاستقرار الاجتماعي سواء في المراحل التشريعية أي سن عقوبة تدون بين حد أدنى وأقصى، أو في مرحلة التقاضي بإعطاء القاضي حرية التقدير والتفريد العقابي، أو في مرحلة التنفيذ. 2- المدرسة الوضعية :من أهم مؤسسي هذه المدرسة “سيزاري لومبروزو” صاحب كتاب الإنسان المجرم، و “انريكو فيري” صاحب كتاب السوسيولوجيا الجنائية و “رافيل جاروفا لوا” صاحب كتاب علم الإجرام. و قد صنف لومبروزو من خلال كتابه المجرمين على أساس نوع الخطورة و تحديد التدابير الملائمة لكل صنف منهم. و يعتبر فيري الجريمة نتيجة لتراكم عوامل داخلية العضوية و النفسية وأخرى خارجية اجتماعية اقتصادية مرتبطة بالمحيط الذي يعيش فيه و تتميز نظريته بأمرين: اهتمامها بتأثير العوامل الاجتماعية في الإجرام، وتأكيد على تفاعل كل من العوامل العضوية النفسية و الأسباب الخارجية في ارتكاب الجريمة بحيث أن كل عامل من هاته العوامل تكون مجتمعة. و أقر “جروفالو” بأهمية العوامل الداخلية في ارتكاب الجريمة. 3- حركة الدفاع الاجتماعي: نشأت هده الحركة سنة 1945 و هي مدرسة للدفاع الاجتماعي تهدف إلى حماية المجتمع و المجرم جميعا من الظاهرة الإجرامية بخلاف المدارس التقليدية التي حصرت معنى الدفاع الاجتماعي في حماية المجتمع من المجرم . و قد ظهر من خلال المناقشات و المؤتمرات الدولية اتجاهين رئيسين في الدفاع الاجتماعي: – اتجاه جرماتيكا :يهدف الاتجاه الأول الذي يتزعمه “جرماتيكا” إلى إبدال نظام قانون العقوبات التقليدي بنظام للدفاع الاجتماعي، بهدف القضاء على فكرة الجريمة والجانح، والمسؤولية و العقوبة، و استبدالها بأفكار أخرى وهي المناهضة للمجتمع، و الذاتية، و التدابير العلاجية و الوقائية . و على هدا الأساس، ف”جرماتيكا” أنكر حق الدولة في العقاب، و أكد على واجب الدول في التأهيل الاجتماعي، فإنكار حق الدولة في العقاب يعني في نضره تسلط الدولة على حقوق الفرد و الإنسان الذي انشأ الدولة، وبما أن الإنسان اجتماعي بطبعه وبذلك لا مجال لاعتراف بالجريمة و المسؤولية الجنائية، وقد ألح على ضرورة إصلاح الشخص المناهض للمجتمع و ّذلك من خلال التدابير الإصلاحية عوض معاقبته . – – اتجاه مارك انسل : يلتقي “مارك انسل” مع “جراماتيكا” في أغراض التدابير الجنائية المتمثلة في تهذيب و إصلاح المجرم، وان الطابع الإنساني ومراعاة أدمية المجرم و كرامته هو الطابع المميز لهده التدابير. و يقول “مارك انسل” أن المجتمع عليه واجب محاربة الإجرام بوسائل عامة تقلل من فرص الوقوع فيه كمحاربة الكحول و المخدرات ووضع سياسة للرعاية و المساعدة الاجتماعية للأفراد ، و أن اتخاذ التدابير الاحترازية يراعي فيه العوامل العضوية و النفسية و الاجتماعية التي المجرم إلى الجريمة، و يجب أن تخضع هده التدابير لمبدأ الشرعية حماية للحقوق و ضمانا للحريات الفردية، لان هدف التدابير التأهيل و الإصلاح، و يتم تأهيل المجرم و إصلاحه بإحدى المهن أو تثقيفه أو علاجه إذا اقتضى الأمر ذلك. الفقرة الثانية: تفريد العقاب في الشريعة الإسلامية إن العقوبات في الإسلام لا تقوم على أساس الانتقام من الجاني، بل، قائمة على ما يحقق مصالح البشر. يقول ابن تيمية :” العقوبات الشرعية إنما شُرعت رحمة من الله تعالى لعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم , ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض”. إن ما يسمى اليوم بتـفـريـد العقوبة هو مصطلح شرع في أصله في الفقه الجنائي الإسلامي ويتجلى ظهوره في الجرائم التعزيرية التي تشكل غالب الوقائع الجرمية التي تحدث في المجتمع. فلقد شدد الإسلام العقوبة على حالات معينة، يعود بعضها إلى جسامة الضرر المترتب على الجريمة، ويعود بعضها الأخر إلى صفة في الجني أو المجني عليه، أو لوحشية الوسائل، أو لدناءة البواعث التي دفعت المجرم لارتكاب الجريمة أو بالنسبة للمجرم العائد الذي يتكرر منه الإجرام، و أخذ بظروف التخفيف في مواضع أخرى. فقد شدد في العقوبة لجسامة الضرر المترتب على الجريمة، فنص على قطع يد السارق ورجله من خلاف: قال لله تعالى في أية الحرابة { إِنَّمَا جَزَاء الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْم}ٌ. و شدد في العقوبة لصفة خاصة في الشخص الجاني، يقول تعالى:{ يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا }. و شدد في العقوبة لحالة العود، حيث تواردت الروايات الدالــة على أن شارب الخمر يقتل في الرابعة، منها ما روي عن الترمذي وأبي داود عن معاوية عن أبي سفيان رضي الله عنه قال، قال: رسول الله – صلى الله عليه وسلم- { من شرب الخمر في الرابعة ف فاجلدوه فان عاد فاقتلوه}. و أقرت الشريعة الإسلامية الإعفاء و التخفيف من العقاب، حيث اتفق الفقهاء على أنه يجوز العفو عن التعزير الذي هو حق العبد، يقول صلى الله عليه وسلم { أقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود}. كما أقرت الشريعة الإسلامية وقف تنفيذ العقوبة، ومن أمثلة ذلك اجتهادات عمر- رضي الله عنه- في وقف تنفيذ العقوبة، في الحالات التالية: – عدم إقامة عمر حد السرقة عام المجاعة: وذلك لما رأى عمر عدم استيفاء الشروط الموجبة لقطع يد السارق الباعثة على تطبيق الحكم، والتي منها شبهة المجاعة الملجئة إلى أخذ حق الغير بدون قصد منه، حيث كان أخذ المال بغير حق أمام ضرورة، فكان بذلك أمام مناط آخر غير المناط العام الذي يوجب الحد، والذي يستوجب تقديم إسقاطه لما قد يفضي إليه تطبيقه من هلاك الأنفس. – قضاء عمر في الرقيق الذين سرقوا ناقة حاطب بن أبي بلتعة فذبجوها واكلوها: يروى أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فنحروها، فرفع ذلك إلى عمر الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله، لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. ومن هذا الأثر نرى أن الفاروق عمر فهم من تشريع قطع اليد أنه عقوبة رادعة لمن يرتكب هذه الجريمة من غير حاجة تلجئه إلى الاعتداء على مال الغير وحين تبين له أن هؤلاء الرقيق اضطروا بسبب ما نالهم من الجوع والحرمان لم ير أن يمضي عليهم حد لسرقة. الجزء الثاني: دور القاضي في تفريد العقوبة للقاضي دور هام في تفريد العقوبة وأنسنتها، ذلك أنّ القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية في تحديد العقوبة المناسبة في حق المتهم الذي ثبتت إدانته. و قد منح المشرّع للقاضي عدة صلاحيات تساعده في تحديد العقوبة المناسبة وفقا لظروف الجريمة وملابساتها وشخصية الجاني وله الحرية في تخفيف العقوبة والنزول بها درجة أو درجتين في سلّم العقوبات الأصليّة أو تعويض العقوبة بخطية مالية وهو ما جاء به الفصل 53 من المجلة الجزائية أو إصدار الحكم مع تأجيل التنفيذ أو كذلك الحكم بعقوبة بديلة تجنب المحكوم عليه الدخول إلى السجن، كما يمكن للقاضي أن يذهب نحو تشديد العقوبة في بعض الحالات. ومن هنا لا بد أن يجتهد القاضي الجزائي من خلال ما يتمتع به من سلطة تقديرية في استخراج التحديد الواقعي للعقوبة، بحسب ملابسات الجريمة وظروف المجرم، فالقاضي ليس آلة ميكانيكية تنتج نفس المحتوى و نفس الشكل.
ويظهر دور القاضي في تفريد العقاب على مستوى تقدير العقاب المسلط على المتهم سواء على مستوى إعتماد ظروف التخفيف و ظروف التشديد { الفقرة الأولى} و تفعيل العقوبات البديلة { الفقرة الثانية }.
الفقرة الأولى: إعمال ظروف التخفيف و التشديد
1- ظروف التخفيف: أقر الفصل 53 م ج مبدأ اعتبار ظروف التخفيف في تقدير العقوبة، و ذلك بالحط في سلم العقوبات درجة أو درجتين أو الحكم بتأجيل التنفيذ، إذ نص صراحة على أنه ” إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تـحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصـل 5 م ج، وإذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنــه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا “.
ولكن ما تجدر الملاحظة إليه أن الفصل المذكور لم يحدد ظروف التخفيف ولم يذكرها لا على سبيل الذكر ولا على سبيل الحصر، وإنما تولت محكمة التعقيب سرد بعضها على سبيل الذكر لا الحصر: - قرار جزائي عدد 10135 مؤرخ في 05/03/1975 ” ظروف التخفيف شعور باطني ناشيء عن أحوال توجب التخفيف اوجب القانون على الحاكم بيانها في حكمه … و من تلك الظروف و أكثرها شيوعا حسن ماضي المتهم و حداثة سنه و البواعث التي دفعته لارتكاب فعله و استفزاز المجني عليه للجاني”. – قرار جزائي عدد 22213 مؤرخ في 14/01/1988 ” يرجع لمحكمة الأصل الحرية المطلقة في تقدير الوقائع وأدلتها واستنتاج الإدانة طالما كان قرارها صادرا على سبب استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد عما له أصل ثابت بالأوراق بدون خطأ أو تحريف كما لهذه المحكمة مطلق الحرية في التخفيف عن البعض والتشديد على من عداه بحسب ما يتراءى لها وما تستنتجه من الوقائع والأوراق وماضي كل منهم وما قام به في تنفيذ الجريمة”.
و قد نص الفصل 37 م ج على أنه لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا عدى الصور المقرّرة بوجه خاص بالقانون، و هو يعطي للقاضي دورا محوريا في إبراز وجود القصد من عدمهن و توقيع العقاب الملائم.
و يطرح الفصل 39 م ج الذي ينص على أنه” لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر. والأقارب هم: أولا: الأصول والفروع، ثانيا : الإخوة والأخوات، ثالثا : الزوج والزوجة. أما إذا كان الشخص المعرّض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقدير درجة المسؤولية”، مسألة السلطة التقديرية للقاضي في تكييف الجريمة من قبل الدفاع الشرعي و ترتيب الأثر القانوني على ذلك. 2- أعمال ظروف التشديد: ظروف الجريمة هي كل ما يحيط بها، فهي عناصر تبعية تفترض وجود الواقعة الأساسية المكونة للجريمة بكامل عناصرها التكوينية، و يختلف ظرف الجريمة عن ركنها تخلف هذا الأخير يعني ألا يوصف الفعل أو الامتناع بأنه جريمة، أما الظرف فإن وجوده أو عدمه لا يؤثر في الوجود القانوني للجريمة و يترتب على تحققه زيادة أو نقص في جسامة الجريمة مما يستوجب تشديد المسؤولية الجنائية أو تخفيفها. و تنقسم الظروف إلى ظروف موضوعية و أخرى مادية و شخصية. * الظروف الموضوعية: و تنقسم إلى ظروف عامة و خاصة. – الظروف العامة: و هي تلك التي يقررها المشرع و يحددها على سبيل الحصر بحيث ينصرف أثرها في تشديد العقاب إلى جميع الجرائم أو عدد كبير غير محدد منها، و من أهم أمثلتها العود، و كذلك حالة تعدد الجرائم… – الظروف الخاصة: و هي تتعلق بالحالة النفسية للجاني أو بصفة فيه، كما هو الحال بالنسبة لظرف سبق الإصرار و الترصد، عندما يدل الترصد على وجود سبق الإضمار … كما تتعلق الظروف المشددة الخاصة بظروف و ملابسات ارتكاب الجريمة أو كيفية تنفيذها، كظرف الكسر و التسلق أو حمل السلاح أو الإكراه أو ظرف الليل أو ظرف التعدد في جريمة السرقة، بل قد يتعلق الظرف المشدد الخاص بصفة في المجني عليه ذاته، مثال ذلك وقوع جريمة القتل على أحد أصول الجاني، و أخيرا فقد يتعلق الظرف المشدد الخاص بالنتيجة الجسيمة التي تترتب على الجريمة حتى ولو كانت هذه النتيجة غير مقصودة من الجاني أو من الجناة في حالة تعددهم، مثال على ذلك حدوث الوفاة أو العاهة المستدامة نتيجة للضرب أو الجرح … * الظروف المادية و الشخصية: تنقسم ظروف الجريمة بالنظر إلى طبيعتها إلى ظروف مادية تتعلق بعنصر من عناصر الركن المادي للجريمة و أخرى شخصية تقترن بالركن المعنوي للجريمة. – الظروف المادية: يعتبر الظرف المادي المشدد هو ما كان خارجا عن شخص الجاني و متعلقا بالجانب المادي للجريمة فيجعله أشد خطرا مما لو تجرد من هذا الظرف. والظروف المادية تتعلق بالفعل الإجرامي من جهة، و قد يرجع ذلك إلى استعمال وسيلة معينة أو ارتكاب الفعل في مكان معين أو وقوعه في زمن معين أو قد تتصل بالنتيجة الإجرامية المترتبة على الجريمة من جهة أخرى، و تتمثل في ازدياد جسامة النتيجة الإجرامية أو موضوع الجريمة. – الظروف الشخصية: تعتبر الظروف الشخصية المشددة هي تلك الظروف التي تتعلق بمرتكب الجريمة شخصيا و لا شأن لها بالفعل المادي المكون للجريمة، و تتمثل في: – الإرادة الجنائية للجاني: أي سبق الإضمار. – صفة الجاني: اتجه المشرع إلى اعتبار صفة الجاني مجرد ظرف مشدد خاص تلحق ببعض الجرائم، و كمثال على ذلك سرقة أجير لمؤجره و الخيانة الموصوفة. – الباعث على السلوك الإجرامي: و هو العامل النفسي الذي يحمل الشخص على توجيه إرادته الإجرامية إلى تحقيق نتيجة، فهو يمثل القوة المكونة للإرادة ثم القوة الدافعة لها حتى تتحقق النتيجة. – علاقة الجاني بالمجني عليه: اتجه المشرع إلى تشديد العقوبة و ذلك في حالة وجود علاقة معينة تربط بين الجاني و المجني عليه مثل قتل الفرع للأصل و الاعتداء بالعنف من الخلف على السلف أو وجود علاقة زوجية مثل الاعتداء بالعنف على القرين. وحسب رأينا فإن المتهمين بمخالفات من اجل خرق الحجر الصحي ومنع التجول، دون توفر حالة الفرار أو العود، يتجه مراعاة ظروف التخفيف بشأنهم، بإعتبار أن الجريمة لا تمثل خطرا على المجتمع و مرتكبيها ليسوا بمجرمين محترفين او بالطبيعة، و من شأن أن يؤدي الحكم على هؤلاء بالسجن إلى تحويلهم إلى مجرمين محترفين، و الاكتفا ء بخطية مالية، و هو ما تسعى إليه الحكومة من خلال إصدار مرسوم يعاقب هؤلاء المخالفين بخطايا مالية إدارية . و لكن يتجه على المحكمة في المقابل التشديد في العقاب بخصوص المصابين بفيروس الكورونا الذين تسببوا في إصابة غيرهم بالعدوى، و الأشخاص الذين فروا من آماكن الحجر الصحي و كذلك الاشخاص و التجار الكبار من المحتكرين، الذين انتهزوا فرصة وباء كورونا و حاجة الناس للقوت لتكوبن الثروة. الفقرة الثانية: تفعيل العقوبات البديلة يلعب القاضي دورا حيويا في تفعيل العقوبات البديلة كلما توفرت الشروط القانونية ، تكريسا لمبدأ تفريد العقاب. و تنقسم العقوبات البديلة للسجن إلى نوعان، عقوبة العمل لفائدة المصلحة و التعويض الجزائي. 1- عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة: للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة وهي الجنح التالية: – بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص: الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد، القذف، المشاركة في معركة، إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد. – بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات: مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار. – بالنسبة للجرائم الرياضية : اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات، ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص. – بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك : الاعتداء على المزارع، الاعتداء على عقار مسجل، تكسير حدّ، الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، السرقة، الاستيلاء على لقطة، افتكاك حوز بالقوة، الإضرار بملك الغير،الحريق عن غير عمد . – بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة : التجاهر بما ينافي الحياء، الاعتداء على الأخلاق الحميدة، السكر المكرر، مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. – بالنسبة للجرائم الاجتماعية: جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية، جرائم إهمال عيال، عدم إحضار محضون، النميمة، الرجوع على الشغب بعد التنفيذ، الإيهام بجريمة، التكفف. – بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية: إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية، الجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك، إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر ، الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع ، الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة، تعطيل حرية الإشهارات. . – بالنسبة لجرائم البيئة : مخالفة قوانين البيئة. – بالنسبة للجرائم العمرانية: جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة. – بالنسبة للجرائم العسكرية: عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. و يشترط لاستبدال السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة وأن لا يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية. وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه في رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتسجيل جوابه. و في صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى. وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل على أن لا يتجاوز هذا الأجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.. و يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلّية أو الجمعيات الخيرية والإسعافيّة أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة. و نقترح أن تكون المخالفات المتعلقة بالحجر الصحي و حظر التجول مما يجوز فيها العمل من اجل المصلحة العامة. 2- التعويض الجزائي: تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة. و لا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار وإن تعدد المتضررين. ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني. فيمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من اجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي. ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة. و لكن لا يمكن للمحكمة مؤسسة التعويض الجزائي بخصوص منع حظر التجول و مخالفة الحجر الصحي العام بإعتبار عدم وجود متضرر. الخاتمة: إن الغاية من العقوبة هي الردع من جهة و إصلاح و إدماج المجرم في المجتمع من جهة أخرى. و هذا الغرض لن يتحقق إلا إذا تحلى القاضي بالشجاعة الكافية و قام بتفعيل سلطته في تفريد العقاب، و ذلك بتوقيع العقاب الملائم و المناسب على المتهم الماثل أمامه، بحسب ما يتوفر لديه من ظروف و ملابسات كل جريمة و الظروف الشخصية للمتهم، و عليه فحص كل قضية حالة بحالة دون تطرف و مغالاة، مرجعه في ذلك ما يحيط بالملف من ظروف موضوعية و شخصية و حالة المتهم و بقراءة متبصرة لأوراقه و لآثار العقوبة المراد توقيعها على المتهم، و ما يمكن أن ينتج عنها من انعكاسات سلبية على المتهم و عائلته و المجتمع. و على القاضي كذلك تطبيق ظروف التشديد بشأن الجرائم الخطيرة، و بشأن كل متهم كائنا من كان دون أي تمييز و مهما علا شأنه.
الدكتور جابر غنيمي
قاض و مدرس جامعي