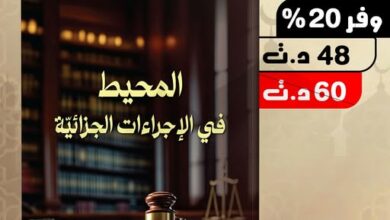مقاومة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري في تونس

مقاومة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري في تونس
فـراس الوكـيـل
قاض بالمحكمة الإدارية بتونس
رئيس الجمعية التونسية للبحوث والدراسات الإدارية
يعدّ واجب تنفيذ الأحكام القضائية متجذّرا في تاريخنا العربي الاسلامي فقد كتب الخليفة عمر ابن الخطاب في رسالته الشهيرة إلى القاضي أبي موسى الأشعريّ: ” لا ينفع تكلّم بحقّ لا نفاذ له”.
كما ورد في مقدّمة ابن خلدون أنّ “الظلم مؤذن بخراب العمران” وأنّ “العدل أساس العمران”. ونعتقد أنّ عدم تنفيذ حكم قضائي هو ظلم مؤذن بالخراب ومقوّض للعدل والأمان.
قيل أنّ آفة الأحكام تنفيذها…وفي نظرنا تكمن آفة الأحكام في عدم تنفيذها. فتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه هو واجب محمول على الإدارة وهو حق بالنسبة للمتقاضي باعتبار أنّ القوة الملزمة للحكم لا تأتي ثمارها إلاّ بوجود قوة تنفيذية تؤدي بالفعل إلى تنفيذ هذا الالتزام، مترجمة بذلك منطوق الحكم على أرض الواقع. ويعدّ تنفيذ الأحكام من متطلّبات دولة القانون ومن مقومات المحاكمة العادلة. وقد سبق للمحكمة الإدارية أن اعتبرت أنّ ” دولة القانون تقتضي نفاذ أحكام القضاء وضمان هذا النفاذ” ( الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 26673 و عدد 26663 بتاريخ 24 ديسمبر 2010) .
ومعضلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية تهمّ أساسا تلك الصادرة عن المحكمة الإدارية لأنّ المشرّع وضع إطارا قانونيا ملائما لمواجهة كل الصعوبات العملية التي قد تحدث من جرّاء عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القاضي العدلي. لكن في النزاعات الإدارية، أين تكون السلطة الإدارية أحد أطراف النزاع وبالنظر للامتيازات الممنوحة لها، يظلّ مشكل عدم تنفيذ الأحكام القضائية مطروحا، بل يمثّل هذا المشكل نقطة ضعف القانون الإداري عامة والقضاء الإداري خاصة، طالما أنّ واجب تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن القاضي الإداري يبقى تحت رحمة الإدارة..
و”يقابل السخاء الدستوري في مجال الحقوق والحريات عدم تنصيص صريح للحق في التنفيذ، والحال أن قول الحق من قبل القاضي لا يكفي بذاته، على أساس أن إيصال الحقوق إلى أصحابها يقتضي توفر وسائل تنفيذية ناجعة وفعّالة. ويبقى تنفيذ الأحكام من أدقّ المعضلات في كلّ النظم القانونية خاصة إذا ارتبطت بنواحي هيكلية تمسّ منظومة التنفيذ ككل ” ( بسَام الكراي،” الحق في التنفيذ من خلال دستور 2014″،الأخبار القانونية ،عدد226-227،أكتوبر 2016،ص 14.).
وبذلك لا يمكن أن تكون مساهمة دستور 2014 في مجابهة معضلة عدم تنفيذ الأحكام الإداريّة سوى مساهمة هشّة تقتضي تظافر الجهود وتكاثفها من قبل القضاء (الجزء الأول) والتشريع (الجزء الثاني)، كلّ من جانبه سواء من خلال اعادة صياغة القوانين الوضعية أو من خلال الاجتهادات القضائية لوضع آليات ناجعة لمواجهة هذه الآفة.
الجزء الأول: جرأة قضائية مرجوَة
تكمن عدم جرأة القاضي في مجال تنفيذ الأحكام من خلال امتناعه ذاتيا عن توجيه أذون (Le professeur B. TEKARI a défini l’injonction comme étant « un ordre adressé par le juge à l’une des parties au litige, en vue d’accomplir une obligation précise »,B. TEKARI, « L’exécution contre l’administration en droit tunisien », R.T.D, 1984, p.361) للإدارة قصد الزامها بالتنفيذ وكذلك في رفض تسليط غرامة زجرية (اعتبرت المحكمة الإدارية أنَ “الغرامة…تعدَ وسيلة ضغط على الإدارة بغية الحصول على تنفيذ حكم قضائي”،م.إ ،حكم إبتدائي عدد18171 /1 بتاريخ 14 نوفمبر 2012.) يتفاقم مقدارها عن كل يوم تأخير عن التنفيذ رغم أنّ الفرصة أتيحت له في أحد القضايا التي رفعت أمامه.
فبالنسبة لرفض القاضي الإداري تسليط غرامة زجرية على الإدارة المتقاعسة في التنفيذ، علَل القاضي الإداري رفضه تسليط تلك الغرامة على الإدارة في إحدى القضايا التي طالب فيها المتضرّر بتسليط غرامة يوميّة يتفاقم مقدارها يوما بعد يوم طالما لم تنفذ الإدارة حكم الإلغاء” بأنّ” لهذه الغرامة صبغة ردعيّة وزجريّة وليس تعويضيّة “( القضيّة عدد 21477 بتاريخ 6 مارس 1998 ، المجموعة، ص.137.) . كما أضافت المحكمة الإدارية أنّ الفصل 10 من قانون 1972 المتضمّن “يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر” ، يندرج في “نطاق القواعد العامّة لنظام المسؤوليّة التي من بينها أن يكون التعويض على قدر الضرر وأن يكون هذا الضرر حالا ومحققا وهو ما لا يتوفر في الغرامة اليوميّة المطلوبة” (قضيّة عدد 21477 بتاريخ 6 مارس 1998، المجموعة، ص.137.). ونعتقد أنَ المحكمة الإدارية قد جانبت الصواب إيمانا منّا بأنّ الضرر المتأتي من الحكم الذي لم ينفّذ سيكون حتما ضررا متواصلا ومتفاقما يوما بعد يوم بما يتناسب مع طبيعة الغرامة الزجرية.
إنّ رفض القاضي الإداري تسليط غرامة يومية على الإدارة المتقاعسة في التنفيذ ليس في محلَّه إذ لا يوجد أيّ نص قانوني يمنع القاضي من إعمال هذه التقنية التي استحدثت لإلزام الإدارة بالتنفيذ. ألم يكن مقصد المشرّع من الفصل 10 المذكور، على خلاف ما وصل إليه القاضي الإداري، يرمي إلى الضغط على الإدارة للتنفيذ (ورد بمداولات مجلس النواب “أنّ المقصود من الفصل 10 من قانون 1972 وضع وسيلة ضغط للمحكوم له لحمل الإدارة على تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية”، أنظر مداولات مجلس النواب ر،ر،ج،ت، 7سبتمبر 1972 ،ص. 438.). كيف للقاضي الإداري الذي يلعب دورا إيجابيا في النزاع والذي نصّب نفسه حامي الحقوق والحريات العامة (القضية عدد 325 بتاريخ 12 أفريل 1981) أن يمتنع عن إعمال هذه التقنية التي تمكَن من إيصال الحقوق لطالبيها؟ ألم يسلَّط القاضي العدلي غرامة يومية لإلزام المدين بتنفيذ التزامه (حكم صادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 21 جانفي 1960،مجلة القضاء والتشريع،1960،ص.45.) والحال أنّه يلعب دوراسلبيّا في النزاع.
أمّا بالنسبة لامتناع القاضي الإداري عن توجيه أذون للإدارة مطالبا إياها بالتنفيذ، فيمكن ارجاع ذلك لسببين اثنين :
يتمثّل السبب الأول في استقلالية الوظيفة القضائية عن الوظيفة الإدارية وما يترتب عنه من اعتبار أنّ مهمة القاضي الإداري تنتهي عند التصريح بالحكم وأنّ التنفيذ موكول للإدارة. إنّ الشق المتبني لهذه النظرية يرى أنّه عملا بهذه الاستقلالية سيمتنع القاضي عن توجيه أذون للإدارة(J. CHEVALIER, « L’interdiction pour le juge administratif de faire acte d’administrateur », A.J.D.A, 1972, p.87 ). أَّمّا في نظرنا فنعتقد أنّ توجيه أذون للإدارة لا يتعارض البتة مع مبدأ استقلالية الوظيفة القضائية عن الوظيفة الإدارية. فتوجيه أذون للإدارة تلزمها بالتنفيذ ينضوي صلب الوظيفة القضائية. فالسلطة القضائية كلّ لا يتجزأ، وسلطة توجيه الأوامر في إطار السهر على حسن تنفيذ الحقيقة القانونية التي يعلنها، لا تمثّل حلولا محل الإدارة بل هي ممارسة كاملة للوظيفة القضائية. لكن لا ندري لماذا بقي القاضي الإداري التونسي متشبثا بنظرية عدم جواز توجيه أذون للإدارة قصد الزامها بالتنفيذ. ألم يحن الوقت بالنسبة للقاضي الإداري التونسي للفظ هذه النظرية البالية دون انتظار منية من المشرع؟
يتمثّل السبب الثاني لرفض القاضي توجيه أذون للإدارة في التقيد بالمنع الوارد صلب الفصل 3 من أمر27 نوفمبر1888 الملغى والذي أصبح مضمنا صلب الفصل 3 من القانون عدد 3 لسنة 1996(ينص الفصل 3 من القانون عدد 38 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص على ما يلي ” ليس للمحاكم العدلية أن تنظر في المطالب الرامية الى إلغاء المقررات الإدارية أو الى الإذن بأي وسيلة من الوسائل التي من شأنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي”.) . استنادا للمنع الذي كان مضمنا بأمر 1888، اعتبرت المحكمة الإدارية أنّه “… لا يدخل في صلاحيات القاضي الإداري توجيه أوامر إلى جهة الإدارة ” ( القضية عدد 274 بتاريخ 17 مارس 1988). إنَ هذا التوجه ولئن كان هناك ما يبرّره في الفترة الأولى لبداية عمل المحكمة الإدارية نظرا لضبابية الجهة القضائية المسلَط عليها هذا المنع في ظلّ أمر 1888، فإنّه لا يستقيم اليوم. فمنذ إصدار القانون عدد 38 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص أصبحت المسألة محسومة، فالمنع وحسب صريح الفصل 3 من القانون سالف الذكر لا ينطبق إلاَ على القاضي العدلي. لكن المثير للاستغراب هو اقرار المحكمة الإدارية نفسها بأنّ المنع المتعلق بعدم إمكانية توجيه أذون للإدارة لا يهمّ إلاَ القضاء العدلي (“وحيث ولئن كان انتصاب القاضي الابتدائي للنظر في قضية الحال بصفته قاضيا إداريا يمكنه من توجيه أوامر للإدارة باعتبار أنَ التحجير الوارد في الأمر المؤرخ في 27 نوفمبر 1888 لا ينطبَق إلاَ على القاضي العدلي..”، حكم صادر بتاريخ 10 مارس 2000، منشور بمجموعة فقه قضاء المحكمة الإدارية لسنة 2000،ص.313.). وفي نفس الوقت تمتنع عن توجيه أذون للإدارة لإلزامها بالتنفيذ. ألا يمكن اعتبار ذلك نكرانا من القاضي الإداري لاختصاصه؟ ألا يرتقي ذلك الى عيب الاختصاص السلبي كما ذهب الى ذلك الرئيس R.ODENT ؟
(Selon le président R.ODENT « il y a incompétence négative, lorsque une autorité se juge à tort incompétente et refuse par ce motif de prendre une décision entrant dans ses attributions légales » , Contentieux administratif : Les cours de droit,Paris,1981,Tome 5,p.1417.).
بالعودة الى القانون التونسي، فإنّ مشكل عدم التنفيذ يمكن حلَه بالرجوع الى أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينصَ على أنّه “يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر”. إنّ عبارة القرارات الواردة صلب هذا الفصل جاءت مطلقة. وبالتالي يجوز على هذا الأساس تسليط عقوبة جزائية متمثلة في السجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية لأعوان الإدارة الذين لا يمتثلون لما أمرت به القرارات القضائية الصادرة في المادة الإدارية عملا بالمبدأ الأصولي “إذا جاءت العبارة مطلقة جرت على إطلاقها”.
الجزء الثاني: إصلاحات تشريعية منشودة
إنّ أحكام الدستور المكرسة للحق في محاكمة عادلة ولواجب تنفيذ أحكم القضاء تقتضي من المشرَع إيجاد وسائل حقيقية وفعّالة يستطيع بها القاضي الإداري أن يحثّ الإدارة على التنفيذ، وعند الضرورة أن يجبرها على ذلك و لوعن طريق الضغط والإكراه. ومن بين هذه الإصلاحات التشريعية نقترح الآتي:
/1 التتبع التأديبي لعون الإدارة المتقاعس في التنفيذ
تمثّل فكرة الأخذ بالمسؤوليّة الشخصيّة للموظف المتسبّب في عدم التنفيذ أحد الحلول الناجعة لضمان تنفيذ أحكام المحكمة الإداريّة حتى لا تتحملّ الخزينة العامّة وبالتالي المواطن التعويض عن الأضرار الحاصلة من جراء عدم تنفيذ الأحكام القضائيّة . حيث يعتبر إقرار المسؤوليّة الشخصيّة للعون العمومي بمثابة “العقاب” المسلّط على العون عند استعماله السلطات الإداريّة الممنوحة له لأغراض بعيدة كلّ البعد عن مقتضيات المصلحة العامّة، وهو ما تؤكده قرارات المحكمة الإداريّة، إذ عادة ما تعتبر تصرف الإدارة الرافضة لتنفيذ الحكم القضائي انحرافا بالسلطة (عصام بن حسن، ” مسؤوليّة الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإداريّة”، “، أعمال ملتقى ” المسؤوليّة الإدارية اليوم”، دراسات قانونيّة 2006، ، ص.262.).
2.اعتبار تقاعس عون الإدارة في التنفيذ خطأ تصرف
أوجد في فرنسا القانون عدد 80-356 الصادر في 16 جويلية 1980 والمتعلق بالغرامات التهديدية المحكوم بها في المادة الإدارية وتنفيذ الأحكام من طرف أشخاص القانون العام وسيلة مفادها إحالة الموظّف الممتنع عن التنفيذ أمام دائرة مراقبة التصرف في الميزانية وذلك في حالة امتناع الموظف المختص عن إصدار الأمر بدفع التعويض المحكوم به في المدة المحددة، وكذلك إذا أدّى امتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، إلى الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة التابع لها. غير أنّ القانون استثنى رجال الإدارة المنتخبين بسبب تأديتهم مهام نيابية، وكذلك أعضاء الحكومة الذين يتمتعون بحصانة. كما تضمّن هذا القانون توقيع غرامة تتراوح بين 100 فرنك وحدَها الأقصى الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف المعاقب وقت ارتكابه المخالفة.
وعليه يقترح تسليط غرامة بعنوان خطأ تصرف ضدّ العون العمومي المخالف من قبل القاضي المالي.
3/تسليط غرامة زجرية على الإدارة المتقاعسة في التنفيذ
“نحو نهاية عدم تنفيذ قرارات القضاء”، هكذا أعلن الأستاذ TERCINET التطوّرات الكبيرة التي عرفها القانون الإداري الفرنسي في مادّة تنفيذ القرارات الصّادرة عن القضاء الإداري بعد صدور القانون عدد 80-359 الصادر في 16 جويلية 1980 والمتعلق بالغرامات التهديدية المحكوم بها في المادة الإدارية وتنفيذ الأحكام من طرف أشخاص القانون العام.
(J. TERCINET, « Vers la fin de l’inexécution des décisions juridictionnelles de l’administration », A.J.D.A, 1981, p3)
هذا القانون يعتبر ثورة حقيقية وانقلابا في المفاهيم المنظمة لعلاقة القاضي الإداري والإدارة، حيث أقرّ للقاضي الإداري الفرنسي إمكانية تسليط غرامة يومية على الإدارة المتعنتة في التنفيذ. هذه الغرامة التي يتفاقم مقدارها عن كل يوم تأخير هي وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ الالتزام المحمول على عاتقه ويتمثل ذلك في مبلغ مالي تدفعه الإدارة المتقاعسة عن التنفيذ بحساب كلّ يوم، أو أسبوع، أو شهر فترة تأخير مما سيؤدي إلى تضاعف المبلغ كلّما ازداد تأخيرها في تنفيذ الأحكام القضائية . في الواقع إنّ للغرامة التهديدية (comminatoire) قوة كبيرة في إلزام الإدارة والضغط عليها للتنفيذ من خلال سريانها تصاعديا، ذلك أن الحكم الصادر بفرضها ليس نهائيا، بل هو حكم وقتي (provisoire) تظل فيه الغرامة مسلَطة على الإدارة إلى أن تقوم بتنفيذ الحكم المسلَط عليها.
في المغرب تنصّ الفقرة الأولى من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية على أنَه “إذا رفض المنفَّذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها. يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة عن ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته”.
4. تجريم الامتناع عن التنفيذ
ينصّ الفصل 111 من دستور 2014 على أنّه ” تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني”. مثَل هذا الحكم الدستوري نتيجة منطقية للحق في التنفيذ الذي لم يكرّسه الدستور بصفة صريحة. لكن هذا الحكم يبقى غير ذي دلالة في ظلّ غياب نظام تشريعي ينظّم شروط المسؤولية من حيث طبيعتها والمعنيين بها والجزاء المترتب عن عدم احترام الحق في التنفيذ كتجريمه مثلا. لذلك ولئن تميّز الفصل 111 بحدّته من خلال الاستعمال الاصطلاحي لعبارة “تحجّر” فانّه يبقى حلاّ فضفاضا . لكن المثير للاستغراب هنا هو أنّ المسودَة الأولى من مشروع الدستور نصَت على أنّه “تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهورية، وعدم تنفيذها من قبل الهيئات المختصّة يعدَ جريمة لا تسقط بالتقادم”، غير أنّ هذه الصياغة الجريئة وقع التخلّي عنها في المسودّات التي تلته وكذلك في النسخة النهائية للدستور. إنّ هذا التراجع عن هذا المكسب، الذي يؤسّس للمسؤولية الجزائية للعون الذي يمتنع عن التنفيذ ،إن دلَ على شيء فانه يدلّ على عدم إيمان واضعي الدستور بمبادئ دولة القانون التي تقتضي أن تكون أحكام القضاء نافذة ولا تترك بيد إدارة متلكئّة. إنّ الانقلاب عن هذا المكسب من شأنه أن يشوّه صورة واضعي الدستور أمام المتقاضين ضحايا إدارة متسلطة ترفض تنفيذ الأحكام القضائية وتحول دون الوصول لحقوقهم.
إنّ المشرع المصري كان أكثر اهتماما وسعيا في الحفاظ على حجية القرارات القضائية من نظيره التونسي، بأن جعل من تجريم امتناع الموظف عن التنفيذ مبدأ دستوريا. فقد أشارت إلى ذلك المادة 100 من الدستور المصري لسنة 2014 بتنصيصها “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله”.
كما نصّت المادة 123 من قانون العقوبات المصري على أنّه: “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أي أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كلَ موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف”.
أمّا في القانون الجزائري، فالمسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ تجد أساسها في المادة 138 مكرر من القانون 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 والتي تنصّ على ما يلي:” كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 دينار جزائري”.
وعليه نقترح تنقيح الفصل 315 من المجلة الجزائية في هذا الاتجاه.
5. إحداث خطة قاضي التنفيذ
أنشأ القانون الإيطالي مؤسسة قاضي الامتثال(le juge d’obtempération) الذي يحدّد محتوى الإجراءات الواجب اتخاذها اثر الحكم بإلغاء القرار الإداري. كما يمكنه في إطار سعيه هذا أن يعيّن مندوبا خاصا(un commissaire aux actes ) بوسعه اتخاذ كلّ القرارات التي تتطلّبها عملية تنفيذ حكم الإلغاء، وتكون قراراته قابلة للطعن وللمراجعة .
(J-P. COSTA, « L’exécution des décisions juridictionnelles administratives en Italie », A.J.D.A, 1994, p.365)
أمّا القانون الألماني فقد أقرّ دعوى قضائية جديدة إلى جانب دعوى الإلغاء تهدف إلى استصدار قرار إداري صريح إثر الحصول على حكم الإلغاء (l’action en émission d’un acte administratif). ولقد رأى البعض أنَ هذه الدعوى قلّصت بشكل كبير من إشكاليات عدم التنفيذ خصوصا عندما تلتزم الإدارة الصمت وتمتنع عن ترتيب آثار الأحكام الصادرة ضدَها .
(M. FORMONT, « Les pouvoirs d’injonctions du juge administratif en Allemagne, Italie, Espagne et France : Convergences », R.F.D.A, 2002, p.557)
والأمل معقود على المشرّع التونسي ليتدخَل بإنشاء مؤسسة قاضي التنفيذ(Juge de l’exécution) تكون مهمَته مراقبة تنفيذ الأحكام والسهر على تنفيذها وأن يزوَده بالوسائل التي تجبر الإدارة على التنفيذ. وهنا نقترح إنشاء دائرة صلب المحكمة الإدارية تسمّى “دائرة تنفيذ الأحكام الإدارية” تسهر على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، ترشد الإدارة للطريقة الأسلم للتنفيذ وإن اقتضى الأمر تحدَد إجراءات التنفيذ. وتكون أحكامها ملزمة للإدارة وهو ما سيميزها بالتالي عمّا تمارسه حاليا المحكمة الإدارية من وظيفة استشارية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية.
خــــــاتـــــــــــمــــــــــة
في انتظار تدخّل حاسم للمشرع، صلب مجلة القضاء الاداري المرتقبة، لتكريس الآليات اللازمة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري، ننتظر الكثير من القاضي الإداري كي يستبق ولا يبقى حبيس إرادة المشرع. فعلى القاضي الإداري، لضمان محاكمة عادلة للمتقاضين، إعمال رقابة قضائية حقيقة ولا “أفلاطونية”، وذلك لا يكون إلاَ من خلال عدم الاكتفاء بقول القانون فقط، بل والسعي أيضا إلى إنفاذه دون انتظار إصلاحات تشريعية قد تأتي وقد لا تأتي. لكن هذه الخطوة تتطلب جرأة ومهارة وخبرة لا يقدر عليها إلاّ القاضي العادل (Le juge équitable) الذي يجمع بين شرعيّة قضائه ومشروعيته، ولو أدّى به الأمر إلى الإعراض عن قساوة القانون والاستنجاد بالمبادئ القانونيّة العامّة (Les principes généraux de droit) ، وعلى وجه الخصوص الإنصاف وهو فضيلة لتجسيم العدل الأمثل (l’équité est la vertu suprême de la justice) حسب عديد الفقهاء.