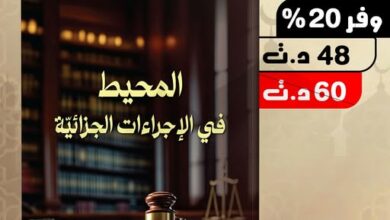قراءة في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

بقلم: الدكتور جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
مدرس جامعي
منذ الاستقلال عام 1956، حظيت المرأة التونسية بجملة من الحقوق والامتيازات
المدنية اعتبرت بمثابة “تحولات ثورية” مقارنة بوضع النساء آنذاك في العالم العربي.
وقد كفلت هذه الحقوق تشريعات “مجلة الأحوال الشخصية” التي تمنع تعدد الزوجات وتمنح
حق الطلاق للمرأة والحق في التعليم والعمل.
لكن هذه الحقوق لم تكن كافية لتحقق للمرأة التونسية المساواة الكاملة مع الرجل ولحمايتها من
العنف سواء داخل محيط الأسرة أو خارجها، فقد ظلت النساء طيلة عقود تحت تأثير مفارقة
جمعت بين التحرر من جهة والتمييز والعنف من جهة أخرى.
فميدانيا، ووفق مسح أجراه “الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري” في العام 2010 (أي
قبل اندلاع الثورة التونسية)، فإن نصف النساء التونسيات تعرضن لشكل من أشكال العنف.
واعتمد هذا المسح الميداني على عيّنة تمثيلية شملت 3873 امرأة ضمن الشريحة العمرية
18 ـ 64 سنة، وأثبت أن 47,6% من النساء في تونس تعرضن لأحد أنواع العنف على
الأقل مرة واحدة طيلة حياتهن، وأن 32,9% من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف على
الأقل مرة واحدة خلال الــ 12 شهرا السابقة.
وفي إطار كشف طبيعة الاعتداءات التي تتعرض لها النساء أظهر المسح أن العنف الجسدي
يمثل 31,7% يليها العنف النفسي بنسبة 28,9% والعنف الجنسي بـ15,7% ثم العنف
الاقتصادي بـ7,1%.
وبعد الثورة التي اندلعت شرارتها الأولى قبل عشر سنوات من أجل تحقيق
حلم التغيير والحرية، حققت تونس خطوات جديدة في مسار ضمان حقوق المرأة ومكافحة
التمييز ضدها.
ففي 2014 رفعت تونس كل التحفظات الخاصة باتفاقية “سيداو” التي صادقت عليها عام
1985، لكنها أبقت على الإعلان العام المتصل بالاتفاقية الذي أكد أن تونس لن تتخذ أي قرار
تنظيمي أو تشريعي من شأنه أن يخالف الفصل الأول من الدستور التونسي الذي ينص على
أن دين الدولة التونسية هو الإسلام.
واتفاقية سيداو هي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، تهدف
للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي هذا الإطار صدر القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11
أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ما اعتبر ثورة تشريعية في هذا السياق.
ويتضمن الفصل الثاني “أن هذا القانون يشمل كل أشكال التمييز والعنف المسلط
على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله.
وللإشارة فقد ورد في وثيقة شرح الأسباب أن هذا القانون يهدف إلى تلافي الثغرات وقصور
النصوص القانونية التي كانت موجودة وذلك من خلال تكريس أوجه الوقاية والحماية من
هذه الظاهرة وتشديد العقوبات المقررة في هذا المجال.
ووفق تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن القانون الجديد يقوم على أربع
ركائز وهي الوقاية من العنف، حماية النساء ضحايا العنف، تجريم مرتكبي
العنف، الإجراءات والخدمات والمؤسسات التي تقدم الإحاطة للنساء ضحايا العنف.
ويشمل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة كافّة أشكال العنف المرتكب ضدّ النساء سواء أكان جسديّاً
أو جنسيّاً أو معنويّاً أو اقتصاديّاً أو حتّى سياسيّاً ويعتبر أن سببه يكمن في التمييز ما بين
النساء والرجال. ويتضمّن هذا القانون أربعة أجزاء: الوقاية والحماية والرعاية والإجراءات.
يحوي القسم المتعلّق بالوقاية بشكل أساسي تدريب كافّة الأطراف الفاعلة والتثقيف على
المساواة بين الجنسين ونبذ العنف. أمّا القسم المتعلّق بالحماية والرعاية فيشتمل على أوامر
الحماية التي تسمح بإبعاد مرتكب العنف عن منزل الضحيّة وإمكانيّة حصول الضحيّة على
مختلف الخدمات (من قبيل المساعدة الطبيّة والقانونيّة والدعم النفسي). وفيما خصّ الشق
المتّصل بالإجراءات، فقد جرى تجريم أفعال جديدة مثل المضايقة المعنويّة بين الزوجين
والتمييز في الأجور والرتبة وأُتيَ على ذكر زنا المحارم وبموجب هذا القانون، لم يعد كذلك
بوسع مرتكبي الاغتصاب الإفلات من الإدانة من خلال الزواج بضحيّتهم.
و يعد هذا القانون ثورة تشريعية لعدة اعتبارات:
أولها: أنه يقطع مع الفلسفة التي كان يعتمدها القانون الجزائي التونسي في مختلف الجرائم
التي يكون سبب ارتكابها أو العامل الذي سهلها الهشاشة الاجتماعية للضحية، وخصوصا
منها الجرائم التي تستهدف المرأة بسبب ميز جنسي. ففيما كان المشرع يبدي في السابق تفهما
لها وتاليا تخفيفا للعقوبات أو فتح أبواب التسوية مراعاة للتقاليد الموروثة، اتّجه مع إقرار هذا
المشروع إلى تشديد العقوبة بالنسبة إلى هذه الجرائم، في محاولة منه لوضع حدّ لهذه التقاليد
المبنية أصلا على اللامساواة. وهكذا، بدل أن يستفيد الجرم المبرر من تفهم المشرع، بات
محلّ تشدده.
ثانيها: أنه ينقل الاعتداءات التي يرتكبها الأفراد بسبب ذاك الميز أو من نتيجة استغلالهم حالة
الهشاشة الاجتماعية من خانة الإعتداءات الفردية إلى نطاق الاعتداء الاجتماعي، مع ما
يوجبه ذلك من مسؤوليات على الدولة منطلقها ضرورة التزامها بالوقاية من العنف. وأثرها
سحب المسؤولية فيها على مؤسساتها.
و لقد ارتأينا في إطار دراسة هذا القانون تخصيص {الجزء الأول} للثورة التي يولدها في
السياسة الجزائية على أن يكون {الجزء الثاني} من ذات البحث مخصصا لمسؤولية الدولة
عن العنف الذي يستند لتمييز اجتماعي.
الجزء الأول: القانون عدد 58 ثورة في السياسة الجزائية
كان التشريع الجزائي التونسي قبل اعتماد القانون الأساسي الخاص بالقضاء على العنف ضد
المرأة يكتفي فيما تعلق بالعنف الأسري بتشديد العقوبة فيما تعلق بالعنف الشديد في صورتين
أولهما العنف الصادر من الخلف على السلف 1 وثانيهما ذاك الصادر من الزوج على زوجه 2 .
بموازاة ذلك، كان يعتد بالإسقاط الذي يصدر عن المجني عليه في هذا العنف كسبب لوقف
التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب وذلك بدعوى سعيه “إلى استبعاد أسباب الشقاق وإفساح
المجال للإصلاح حفاظا على الأسرة” 3 .
كما كان ذات القانون يجازي مغتصب القاصرة في صورة تزوجه بضحيته بإعفائه من
الملاحقات الجزائية بدعوى أن ذاك الزواج يحقق المصلحة الاجتماعية للمغتصبة خصوصا
وأن المغتصبة مارست علاقة جنسية رضائية.
1 القانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 02-07-1964 المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية التونسية كرس اعتداء الخلف على السلف كسبب
لتشديد العقاب
2 بموجب القانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 -07- 1993 المتعلق بتنقيح الفصل 218 من المجلة الجزائية اعتمد العنف من القرين
كسبب لتشديد العقاب
3 رد وزير العدل على استفسارات النواب بجلسة مناقشة مشروع تنقيح الفصل 218 من المجلة الجزائية – مداولات مجلس النواب الدورة
التشريعية 1992-1993 – المدة النيابية الثامنة –السنة الرابعة والثلاثون – عدد43
وقد كشفت تجربة ربع قرن فشل هذه المقاربة التشريعية في الحد من ظاهرة العنف المستند
للنوع الاجتماعي والتي باتت حسب الإحصائيات الرسمية التونسية تشمل 47،6 بالمائة من
النساء 4 .
فاعتمدت الحركة النسوية التونسية هذا المعطى لتدين السياسة التشريعية التي تكرس ثقافة
الإفلات من العقاب 5 ولتضغط من أجل حمل الدولة 6 التونسية على ملاءمة التشريع الوطني
مع المواثيق الدولية خصوصا منها الإعلان الأممي للقضاء على العنف ضد المرأة لسنة
1993 7 . وتعد بالتالي الأحكام الجزائية التي تضمنها قانون القضاء على العنف ضد المرأة
طرحا بديلا لسياسة جزائية ثبت فشلها بما يستدعي البحث عن خصوصيات هذا البديل.
و قد حرص المشرع في طالع قانونه وتحديدا في الفصل الثالث منه على تحديد مقصوده
بالعنف. فميز بين العنف الجسدي و النفسي {الفقرة الأولى} والعنف الجنسي { الفقرة
الثانية} والعنف الاقتصادي { الفقرة الثالثة} والعنف السياسي { الفقرة الرابعة}. وقد كان
لهذا التفصيل النوعي أثره في توجيه الجهد التشريعي في تكريسه لسياسته الجزائية الجديدة.
الفقرة الأولى: العنف الجسدي والمعنوي: رؤية مغايرة
عرف القانون العنف البدني بكونه “كل فعل ضار يمس بالحرمة أو بالسلامة الجسدية للمرأة
أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق أو بتر أجزاء من الجسم
والاحتجاز والتعذيب” 8 .
أما العنف المعنوي فقد عرفه بكونه “كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو
الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها
4 ندوة جمعية النساء الديمقراطيات – كيف نضع حدا للعنف المسلط على النساء – 23-05-2015
5 الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20-12-1993
6 مسح ميداني أجراه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتونس حول عينة ممثلة متكونة 3873 امرأة -يراجع شرح أسباب تقديم مشروع
القانون عدد 60 لسنة 2016
7 الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20-12-
1993
8 الفصل 3
من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم
فيها” 9 .
وفي إطار تحقيق هدف القانون تم :
1- التشديد في عقوبات الجرائم:
شمل التنقيح جرائم العنف الشديد المجرد 10 والعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني 11 والعنف
الناجم عنه موت 12 والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا 13 والتهديد بسلاح 14 . وكان ذلك في سياق
متجانس، فأرسى الأحكام التالية:
أولا: فيما تعلق بجريمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد، حذف اعتماد إسقاط القرين كسبب
لإيقاف المحاكمات والتتبعات وتنفيذ العقاب. وهذا يحقق هدف منع الإفلات من العقاب ويؤكد
أن العنف الأسري جريمة لا يحق للمجتمع غض الطرف عن تتبعها بدعوى الحفاظ على
الروابط الأسرية.
ثانيا: اعتبر كل عنف يستهدف “شخصا” محل حماية طبق نصه ظرف تشديد للعقوبة. وإذ
يوحي عنوان القانون بأنه يرمي إلى حماية المرأة دون سواها، فإن أحكامه وخصوصا منها
تلك التي تتصل بالجانب الجزائي تتجاوز ذلك كونها تتجه نحو حماية الفئات الاجتماعية
الهشة بصرف النظر عن جنسها. وفي نطاق هذه المقاربة الشاملة، شدد المشرع العقوبات
الجزائية استنادا لعناصر ذات علاقة هي الضحية وملابسات الواقعة وصفة الجاني 15 .
9 الفصل 3
10 نص الفصل 15 من مشروع القانون على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 218 من المجلة الجزائية
11 الفصل 219 من المجلة الجزائية
12 الفصل 208 من المجلة الجزائية
13 الفصل 222 من المجلة الجزائية
14 الفصل 223 من المجلة الجزائية
15 في مختلف قضايا العنف الجسدي والمعنوي اعتمد القانون ظروف التشديد التالية: إذا كانت الضحية طفلا // إذا كان الفاعل من أصول أو فروع
الضحية من أي طبقة // إذا كانت للفاعل سلطة على الضحيّة أو استغل نفوذ وظيفه // إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد
الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين // إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل // إذا كانت الضحية
شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو
تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
فيما يتعلق بظروف التشديد المتعلقة بالضحية أو بملابسات واقعة الاعتداء، اتجه الإصلاح
التشريعي للإحاطة بكل حالات الاعتداء التي تستهدف” طفلا” أو “ضحية مستضعفة بحكم
صغر سنها أو كبر سنها أو مرضها الخطير أو حملها أو قصورها البدني أو الذهني” وتلك
التي يكون الدافع عليها محاولة منع الضحية من ممارسة حقها في التقاضي. كما فرض تشديد
العقوبة في حال تعدد الفاعلين أو حمل الجاني لسلاح أو إذا كان الدافع على الجرم محاولة
إرغام الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه 16 . ويظهر هذا التوسع في ورش الإصلاح
إيجابيا لاعتبارين: أولهما أنه ينسجم مع فلسفة القانون التي تنبذ كل أشكال التمييز الجنسي
16 لفصل 218 (فقرة ثانية جديدة) – ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
إذا كانت الضحية طفلا.
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن
جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة) – ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:
إذا كانت الضحية طفلا
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن
جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.
الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة) – ويكون العقاب مضاعفا:
إذا كانت الضحية طفلا،
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن
جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.
وثانيهما أنه تصور يُرشد العمل التشريعي ويمنع تعدد التنقيحات التي قد تطال النص القانوني
الواحد.
أما فيما يتعلق بصفة الجاني كظرف تشديد، فقد ميز المشرع بين ثلاث حالات تكون فيها
صفة الجاني ظرف تشديد أولها أن يكون الجاني صاحب سلطة على الضحية وثانيها أن
يكون أصلا أو فرعا للضحية وثالثها أن يكون قرينا لها.
ويلحظ في هذا الإطار أن تطور المقاربة التشريعية ذهب هنا في اتجاهين: أولهما اعتبار
اعتداء الأصل على الفرع ظرف تشديد وثانيهما التوسع في مفهوم القرين.
2- التشدد مع الأصول فيما يصدر عنهم من عنف:
اتجهت السياسة الجزائية التونسية قبل هذا التعديل التشريعي إلى تشديد العقوبة في
الإعتداءات التي تصدر من الخلف على السلف، فيما اعتبرت أن الاعتداء بالعنف الذي لا
يترك أثرا معتبرا متى كان الدافع عليه تأديب الطفل لا يعد جرما موجبا للمؤاخذة.
3- التوسع في مفهوم القرين:
كان مفهوم القرين المعتد به كسبب لتشديد العقاب يختزل في الزوج. وينهي القانون هذا
التصور الضيق للعلاقة الأسرية، ليشمل الزوج السابق في إطار مقاربة تستلهم من الواقع
الاجتماعي ضرورة زجر الاعتداءات المتنامية التي تتم بعد انفصام الرابطة الزوجية،
والخطبة والخطبة السابقة 17 .
17 الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة) – ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
إذا كانت الضحية طفلا.
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن
جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
ويلاحظ هنا أن المشرع التونسي لم يعرف بشكل دقيق الخطبة والتي تظل واقعة اجتماعية
وينتظر بالتالي أن يعطي فقه القضاء تعريفا لهذه المؤسسة. ويؤمل هنا أن يتجه هذا التعريف
للتلاؤم مع الواقع الاجتماعي فيتوسع فيها لتشمل مختلف العلاقات الحميمية التي كان هدف
التدخل التشريعي منع استغلالها للاعتداء على الحرمة الجسدية للقرين.
4- تجريم أفعال لم تكن مجرمة:
جرم القانون بمقتضى الفصل 224 فقرة ثانية جديد من المجلة الجزائية “اعتياد سوء معاملة
قرين أو شخص في حالة استضعاف أو له سلطة عليه”. وينسجم هذا النص الجزائي الجديد
مع أحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يلزم القرين بحسن معاملة قرينه.
كما جرم المشرع بإضافته لفقرة ثالثة للفصل 221 من المجلة الجزائية “الإعتداء الذي ينتج
عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة”. ويستهدف هذا التجريم أساسا ختان
الإناث وان كان الفصل القانوني يستوعب الأفعال التي قد تستغرق ركنه المادي دون أن
تكون تلك غايتها. وقد يجد تجريم ختان الإناث الذي لا يحصل فعليا في تونس، مبرره بما تم
تداوله إعلاميا حول تحريض دعاة سلفيين عليه.
فيكون بالتالي دور التشريع حماية المرأة من خطر محتمل حدوثه قد يستهدفها بفعل تغير
الثقافة الدينية والاجتماعية نتيجة انفتاح جانب من المجتمع على التيارات السلفية. وتجدر
الملاحظة هنا إلى غموض في العقوبة. ففيما جاء فيه “ويعاقب بذات العقوبة”، فإن النص لم
يبين إن كانت العقوبة التي أحال عليها هي التي ورد ذكرها بالفقرة الأولى من الفصل القديم
أي السجن مدة عشرين عاما أو تلك التي وردت بفقرته الثانية وهي الإعدام.
ونرجح هنا أن تكون العقوبة المقصودة هي تلك الواردة بالفقرة الأولى أي السجن مدة
عشرين عاما على اعتبار أن عقوبة الإعدام اقترنت بالموت وهي غير صورة التجريم
الجديد. وما يدعم هذا الرأي أن المشرع في الجرائم الجنسية انتهى لحذف عقوبة الإعدام في
جرائم الاغتصاب.
الفقرة الثانية: جرائم العنف الجنسي: ثورة تشريعية مكتملة الأركان
يسلط الفصل 227 من المجلة الجزائية – قديم على عقوبة الإعدام على كل من واقع أنثى
غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به وعلى كل من واقع أنثى سنها دون العشرة
أعوام. ويحدد كعقوبة للمواقعة بدون رضا السجن المؤبد في غير تينك الصورتين مع
افتراضه انعدام الرضا كلما كان سن المجني عليها دون ثلاثة عشر عاما.
كما يسلط الفصل 227 مكرر من ذات المجلة عقوبة ستة أعوام سجنا على من يواقع طفلة
سنها دون الخمسة عشر عاما بدون عنف ويحط عقوبة ذات الفعل إلى خمسة أعوام متى كان
سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما كاملة ودون العشرين عاما. وهو ينص على أن
زواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.
لقد جرم الفصل 227 جديد من المجلة الجزائية “الإغتصاب” وبيّن أن ركنه المادي يتمثل
في “كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون
رضا”. و حدد الفصل 227 مكرر جديد من ذات المجلة الركن المادي للجرم موضوعه
“بالإتصال الجنسي بطفل كان ذكرا أو أنثى برضاه”.
وأضحى عملا بالصياغة الجديدة للفصلين المذكورين الإيلاج في العلاقات الجنسية غير
الرضائية الركن الذي يفرق بين الإغتصاب والمفاحشة التي يكون الفعل المجرم فيها غيره
من الممارسات الجنسية. وأضحى “الإتصال الجنسي” مطلقا الركن المكون لجريمة
اغتصاب قاصر برضاه.
يطيح مفهوما “الإيلاج ” و”الاتصال الجنسي” بمفهوم “المواقعة من المكان الطبيعي” الذي
كان يتم بالاستناد له تجريم الممارسات الجنسية والتمييز بينها. ويعد هذا التطور التشريعي
من أهم الاحكام التي أرساها القانون الجديد لكونه يطيح بالتمييز الجنسي و يمس بالتالي
بعلة تجريم العلاقات المثلية بما ينتظر معه أن يكون له تأثير مباشر عليها في التطبيق
القضائي بشكل آني لما يفرضه من التباس في تحديد ركنها المادي وينتظر معه أن يكون له
أثر مستقبلي في موقف المشرع من تجريمها.
فرض بالتالي التصور الجديد للجرائم الجنسية بعدا حقوقيا في صناعة السياسة الجزائية وهو
بعد تأكد في مراجعة سن التمييز الجزائي الجنسي الذي بات ستة عشر عاما كاملة وفي
فرض أن يحتسب أجل التقادم في الجرائم التي تستهدف القصر من تاريخ ترشدهم. كما تأكد
هذا البعد الحقوقي باعلان نهاية الإجازة التشريعية للزواج من المغتصبة كسبب للإفلات من
العقاب.
وفي ذات السياق، كان إلغاء القانون الجديد عقوبة الإعدام التي كانت مقررة بالفصل 227
من المجلة الجزائية خطوة حقوقية لافتة الأهمية لم يعرفها سابقا العمل التشريعي التونسي
ونأمل أن تكون فاتحة لممارسة تشريعية حقوقية تعتمد عند كل إصلاح يمس المنظومة
الجزائية مستقبلا، ليكون القانون الجزائي قانونا حاميا للحقوق.
الفقرة الثالثة: تجريم العنف الاقتصادي:
كان القانون التونسي يجيز صراحة تشغيل الأطفال الذين يتجاوز سنهم الستة عشر عاما
كعملة منازل 18 . وأدى غياب الردع الجزائي إلى تفشي تشغيل الأطفال ممن هم دون ذلك سنا
كعملة منزليين. واتجه القانون الجديد في الفصل 20 منه للقطع الكامل مع هذا الموقف
التشريعي الذي يشكل اعتداء على حقوق الطفل 19 . كما أنه حارب الممارسات الاجتماعية التي
تعمق سلبياته: فجرم تشغيل الأطفال كعملة منزليين وفرض عقوبة سجنية على من يخالف
ذلك. وفي ذات الاستعمال للقانون الجزائي كسلاح في مقاومة التمييز الاقتصادي الذي
يستهدف الفئات الهشة، جرم الفصل 19 من ذات القانون كل الممارسات التي قد تعتمد في
سوق الشغل وتؤدي لفرض تمييز جنسي ضد المرأة سواء على مستوى تأجيرها أو حقها في
التدرج الوظيفي 20 .
18 ينص الفصل 2 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 01-07- 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل على أنه ” يحجّر تشغيل الأطفال
الذين تقل سنهم عن 16 عاما كعملة منازل “
19 يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة
منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ويبدو الإلتجاء للتجريم مفيدا على اعتبار أن الممارسة وخصوصا منها في القطاع الفلاحي
كشفت عن فشل في تحقيق شعار منع التمييز بين الجنسين الذي يكرسه قانون الشغل
التونسي.
يستند بالتالي استعمال القانون للأحكام الجزائية في التصدي للعنف الاقتصادي لرؤية
واضحة. وهو يهدف لاعتماد ما لهذه المادة من بعد زجري لمنع اعتداء المجتمع على الحقوق
المكرسة. في المقابل، يبدو اتجاه المشرع لذات السلاح الجزائي في مواجهة ما سماه عنفا
سياسيا موقفا يفتقر لذات الرؤية.
الفقرة الرابعة: تجريم العنف السياسي: خطاب سياسي في نص جزائي:
العنف السياسي يعرف بكونه “كل عنف أو ممارسة يهدف مرتكبه إلى حرمان المرأة أو
إعاقتها من ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق
والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.”
و لقد نص الفصل 18 على انه” يعاقب كلّ مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف
دينار.
وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا”.
20 يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله:
حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ويلاحظ هنا غياب الوضوح في تحديد الركن المادي للجريمة بما يطرح السؤال عن استجابة
النص القانوني لمعايير صياغة النصوص الجزائية التي تقتضي أن تكون الأفعال المجرمة
واضحة ومحددة دون التباس. ويرجح أن يكون الهدف من تجريم ما سمي بالعنف السياسي
الدعاية السياسية للقانون في ظل الاحتفاء العام بأن تكون تونس الدولة التاسعة عشرة في
العالم التي تعتمد قانونا مماثلا. وهي دعاية لم يكن هذا القانون في حاجة لها اعتبارا لأهمية
المكتسبات التي يبشر بها.