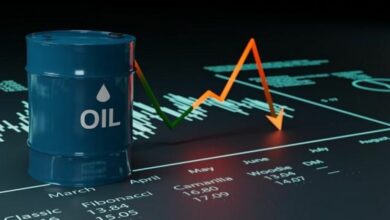حضرموت بين سلطة وافدة وسلطة متجذرة

بقلم د. محمد جمال عبدالناصر بن عبود
يتضح عند قراءة تاريخ السلطنة القعيطية في حضرموت أن هذا الكيان السياسي لم يقم على اندماج اجتماعي حقيقي مع البيئة الحضرمية، بل نشأ في سياق خارجي ثم فُرض على الداخل بقوة المال والسلاح والتحالفات الدولية. فالقعيطيون لم يتشكلوا داخل حضرموت بوصفهم امتدادًا لبنيتها القبلية أو الدينية، وإنما برزوا سياسيًا في الهند في ظل دولة نظام حيدر آباد، حيث خدم زعماؤهم في الجيوش المحلية واكتسبوا ثروة ونفوذًا، ثم عادوا لاحقًا إلى الساحل الحضرمي حاملين نموذج حكم منفصل عن المجتمع الذي حكموه.
وتشير مصادر تاريخية متعددة إلى أن عددًا من حكام القعيطي، خصوصًا في المراحل الأولى والمتوسطة من عمر السلطنة، لم يكونوا متقنين للغة العربية إتقانًا يسمح لهم بإدارة شؤون مجتمع عربي قبلي معقد كحضرموت. فقد كانت لغات التعامل داخل البلاط القعيطي هي الأردية والفارسية، ثم الإنجليزية لاحقًا، وهو ما فرض الاعتماد على مترجمين ووسطاء محليين في المراسلات والقضاء والجباية. هذا الحاجز اللغوي لم يكن تفصيلاً هامشيًا، بل أسهم في تعميق القطيعة بين السلطة الحاكمة والمجتمع، وأضعف قدرة القعيطيين على فهم التوازنات القبلية والدينية الدقيقة في وديان حضرموت.
كما أن عدم استقرار السلاطين القعيطيين في المكلا يُعد سمة جوهرية من سمات هذا الحكم. فالمكلا، رغم كونها عاصمة رسمية، لم تكن مقر إقامة دائمة لمعظم الحكام، إذ فضّلوا الإقامة في الهند أو عدن أو الحجاز، تاركين إدارة البلاد لنُظّار ووكلاء محليين. وقد أدى هذا الغياب المتكرر إلى تحول السلطة القعيطية إلى سلطة اسمية في مناطق الداخل، حيث كانت القبائل والمشيخات الدينية هي صاحبة النفوذ الحقيقي، بينما اقتصر دور الدولة على تحصيل الضرائب أو التدخل العسكري عند الضرورة.
ويبرز وادي دوعن مثالًا واضحًا على هذا العجز البنيوي. فقد ظل الوادي، لعقود طويلة، خاضعًا لسلطة آل العمودي، الذين جمعوا بين النفوذ الديني والزعامة الاجتماعية والتحالفات القبلية الواسعة. ولم تكن قوة العمودي مستمدة من السلاح وحده، بل من شرعية محلية راسخة جعلت المجتمع الدوعني يرى فيهم مرجعية طبيعية لإدارة شؤونه. أمام هذا الواقع، عجز القعيطيون عن بسط نفوذ فعلي ومستقر على دوعن، واضطروا إلى اللجوء إلى الحملات العسكرية والتحالفات القسرية، وهي وسائل لم تنتج ولاءً حقيقيًا، بل رسخت حالة من الرفض الكامن.
أما فيما يتعلق بأصل القعيطي، فإن الوثائق البريطانية والدراسات الأكاديمية الحديثة تجمع على أن القعيطيين ينتمون إلى قبائل يافع، وتحديدًا إلى فخذ القُعطة من بني مالك، وأن صعودهم السياسي ارتبط بالهجرة اليافعية إلى الهند. غير أن محاولات لاحقة سعت إلى إعادة صياغة هذا الأصل وربطه بجذور حضرمية أقدم، في سياق البحث عن شرعية محلية لحكم واجه رفضًا اجتماعيًا في الداخل. هذه السرديات المتأخرة لا تسندها وثائق معاصرة لمرحلة النشأة، بل ظهرت بعد ترسخ السلطنة ومحاولتها تثبيت وجودها سياسيًا واجتماعيًا.
وقد لعبت الحماية البريطانية دورًا حاسمًا في بقاء السلطنة القعيطية أكثر مما لعبه قبول المجتمع المحلي. فبريطانيا رأت في القعيطيين أداة مناسبة لتأمين الساحل الحضرمي وموانئه، وضمان استقرار خطوط الملاحة في بحر العرب، ولذلك وفرت لهم الغطاء السياسي والدعم غير المباشر. لكن هذا الاعتماد المفرط على القوة الخارجية جعل السلطنة هشّة من الداخل، بحيث إن تراجع النفوذ البريطاني في ستينيات القرن العشرين كشف فراغًا سياسيًا عميقًا.
وعندما انسحبت بريطانيا، لم تكن السلطنة القعيطية تمتلك قاعدة اجتماعية أو مؤسسات وطنية قادرة على الصمود. فسقطت المكلا بسرعة، وانهارت السلطة دون مقاومة تُذكر، لا لأن القوة الثورية كانت ساحقة فحسب، بل لأن الدولة نفسها كانت مفصولة عن المجتمع الذي حكمته. وهكذا انتهت السلطنة القعيطية بوصفها مثالًا على كيان سياسي قام على التحالف الخارجي والسلطة الاسمية، وعجز عن التحول إلى دولة متجذرة في محيطها الاجتماعي والتاريخي.
وإذا ما أُعيد تفكيك المشهد زمنيًا وبالأسماء، فإن صورة الضعف القعيطي أمام القوى المحلية تتضح أكثر. فقد بدأ النفوذ القعيطي الفعلي في الساحل الحضرمي مع عمر بن عوض القعيطي في خمسينيات القرن التاسع عشر، ثم تعزز في عهد ابنه عوض بن عمر القعيطي الذي أعلن نفسه سلطانًا عام 1881م، قبل أن تُبرم معاهدة الحماية البريطانية رسميًا سنة 1888م. هذه المعاهدة منحت القعيطي غطاءً سياسيًا، لكنها لم تمنحه قبولًا داخليًا، خصوصًا في مناطق الوادي حيث كانت موازين القوة مختلفة جذريًا.
في المقابل، كانت دولة آل العمودي في وادي دوعن قائمة قبل ذلك بقرون، وقد برز من أعلامها عدد من الشخصيات ذات النفوذ الديني والسياسي، وعلى رأسهم الشيخ سعيد بن عيسى العمودي، الذي استطاع منذ القرن السابع عشر أن يؤسس كيانًا متماسكًا جمع بين الزعامة الدينية والقيادة القبلية. واستمر هذا الإرث حتى القرن التاسع عشر، حيث كان آل العمودي يحكمون دوعن حكمًا فعليًا، يديرون شؤونه، ويعقدون التحالفات، ويفرضون الإتاوات، ويمتلكون حصونًا وقلاعًا منيعة مثل حصون بضه وقيدون ومواقع استراتيجية داخل الوادي.
عندما حاول القعيطيون التوسع نحو الداخل، واجهوا مقاومة مباشرة من دولة العمودي. وتشير المصادر إلى أن الصدامات الكبرى وقعت في تسعينيات القرن التاسع عشر، وبلغت ذروتها سنة 1899م (1317هـ)، عندما شن القعيطي حملة عسكرية واسعة لإسقاط النفوذ العمودي. ورغم نجاحه العسكري المؤقت، فإن هذه السيطرة لم تُلغِ المكانة الاجتماعية والدينية لآل العمودي، بل بقي نفوذهم حاضرًا في المجتمع، واستمرت قدرتهم على التأثير في السكان حتى بعد سقوط دولتهم سياسيًا.
وعند مقارنة السلطنة القعيطية بالسلطنة الكثيرية، يظهر الفرق بوضوح. فالكثيريون، رغم ضعفهم في مراحل لاحقة، ينتمون تاريخيًا إلى حضرموت، ويتحدثون لغتها، ويقيمون بين أهلها، وقد حكموا سيئون وتريم قرونًا طويلة قبل مجيء القعيطي. أما القعيطيون فكانوا قوة صاعدة وافدة، اعتمدت على المال والتحالف الخارجي أكثر من اعتمادها على الجذور المحلية. ولهذا السبب، ظل نفوذهم هشًا في الداخل، بخلاف الكثيريين الذين حافظوا على قدر من الشرعية الاجتماعية حتى سقوطهم.
وتكشف أسماء السلاطين المتأخرين حجم هذا الانفصال؛ فالسلطان غالب بن عوض القعيطي، آخر سلاطين الدولة، لم يستقر في المكلا، ولم يكن حاضرًا ميدانيًا عند تصاعد المد الثوري في ستينيات القرن العشرين، ما جعل سقوط المكلا في سبتمبر 1967م يتم بسرعة لافتة، ودون معركة حقيقية. في حين أن مناطق مثل دوعن كانت قد خرجت فعليًا من السيطرة القعيطية قبل ذلك، وأصبحت بيئة حاضنة للنفوذ المحلي والثوري معًا.
إن الاسترسال في تجربة الدولة العمودية يكشف أنها لم تكن مجرد مشيخة عابرة، بل دولة محلية مكتملة الأركان بمعايير عصرها، سبقت القعيطيين في دوعن بقرون، وامتلكت عناصر القوة والشرعية التي عجزت السلطنة القعيطية عن تعويضها أو إحلالها. فقد نشأت الدولة العمودية في وادي دوعن منذ القرن السابع عشر الميلادي، مستندة إلى مكانة آل العمودي العلمية والدينية، حيث جمع شيوخها بين الزعامة الروحية والقيادة السياسية، وهو نموذج حكم مألوف في حضرموت، وأكثر قبولًا لدى المجتمع من الحكم العسكري أو المفروض خارجيًا.
برز من آل العمودي عدد من الأسماء المؤثرة، وفي مقدمتهم الشيخ سعيد بن عيسى العمودي، الذي أسس نواة الدولة ورسّخ نفوذها في دوعن الأعلى والأسفل، معتمدًا على شبكة تحالفات قبلية واسعة، وعلى ولاء السكان القائم على الثقة والارتباط الديني، لا على القهر. وقد امتلكت الدولة العمودية حصونًا ومراكز قوة استراتيجية داخل الوادي، مثل حصون بضه وقيدون ومواقع جبلية حصينة، مكّنتها من الدفاع عن نفسها أمام الحملات الخارجية، سواء القادمة من الكثيريين أو لاحقًا من القعيطيين.
اقتصاديًا، سيطرت الدولة العمودية على النشاط الزراعي في وادي دوعن، وهو شريان الحياة في المنطقة، وأشرفت على توزيع المياه والأراضي، وضمنت الأمن للقوافل التجارية العابرة بين الساحل والداخل، ما منحها موردًا ماليًا ثابتًا، وأكسبها نفوذًا يتجاوز حدود الوادي. كما لعب آل العمودي دورًا مهمًا في فض النزاعات القبلية، وتطبيق الأعراف المحلية، وهو ما جعلهم مرجعية حقيقية للسكان، لا مجرد سلطة سياسية.
وعندما واجهت الدولة العمودية التوسع القعيطي في أواخر القرن التاسع عشر، لم يكن الصراع بين كيانين متكافئين من حيث الطبيعة، بل بين دولة محلية متجذرة، وسلطة وافدة تعتمد على المال والسلاح والدعم الخارجي. ورغم أن الحملة القعيطية سنة 1899م نجحت في إسقاط الحكم العمودي عسكريًا، فإنها فشلت في تفكيك البنية الاجتماعية التي أسسها آل العمودي، وبقي تأثيرهم حاضرًا في المجتمع الدوعني، سواء عبر العلماء أو الزعامات الاجتماعية المرتبطة بهم.
ولهذا، فإن سقوط الدولة العمودية لا يمكن قراءته بوصفه نهاية نفوذها، بل انتقالًا من سلطة سياسية ظاهرة إلى نفوذ اجتماعي وديني عميق، استمر في تقييد سلطة القعيطيين، وأفشل محاولاتهم لبسط حكم فعلي ومستقر في دوعن. ومن هنا يتضح أن القعيطي ورث الأرض بالقوة، لكنه لم يرث الناس ولا ولاءهم، وأن وادي دوعن ظل، حتى سقوط السلطنة القعيطية نفسها، فضاءً مقاومًا للسلطة المفروضة، ومتمسكًا بتقاليده وبالرموز التي نشأت من داخله.
د. محمد جمال عبدالناصر بن عبود