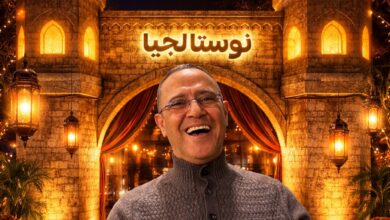الاحتراق الوظيفي للكفاءات: جريمة صامتة تهدد مستقبل الاوطان

بقلم الدكتورة عقيلة بالطيب
في السنوات الأخيرة، ترسّخ في الوعي الجماعي تصورٌمشوَّه ومجحفٌ عن المديرين العامين في الوظيفة العمومية، حيث جرى اختزالهم في صورة امتيازات وهمية وسيارات إدارية فاخرة ورواتب مرتفعة، بينما تمّ تجاهل الحقيقة الأعمق والأقسى، أن أغلب المديرين العامين في تونس هم كفاءات أفنت عمرها في خدمة الدولة، ودفعوا من صحتهم، ومن استقرارهم النفسي، ومن استقرار حياتهم العائلية، ثمناً لمسؤولية ثقيلة لا يعلمها إلا من عاشها.
المدير العام في تونس لا يعمل في ظروف مريحة، ولا يتحرك داخل منظومة واضحة الرؤية أو مستقرة القرار. يشتغل تحت ضغط دائم، في غياب استراتيجية وطنية ثابتة، ووسط سياسة استعجالية تُدار بمنطق “توا توا”، حيث يُطلب الإنجاز الفوري دون توفير الإمكانيات، وتُحمَّل المسؤوليات دون حماية أو اعتراف. هو مطالب بالنجاعة، بالنتائج، وبالوجود الميداني الدائم، وفي المقابل يُحرم من أبسط شروط العمل اللائق.
خلافاً للصورة النمطيىة السائدة، فإن الامتيازات التي يُتحدث عنها كثيراً لا ترقى إلى حجم الجهد المبذول ولا إلى مستوى التكوين العلمي الاكاديمي العالي الذي يحمله هؤلاء الإطارات، من شهادات عليا وخبرات ومهارات تراكمت على مدى عقود. سيارات إدارية متهالكة، مصاريف تُدفع من الجيب الخاص، ساعات طويلة من العمل لا تُحتسب، وتدخل دائم في الحياة الشخصية… كل ذلك أصبح جزءاً من يوميات المدير العام.
ولا يمكن الحديث عن الاحتراق الوظيفي دون التوقّف عند العبء الإنساني الخفي الذي يحمله المدير العام. فهذا الأخير لا يعمل فقط بعقله ووقته، بل بأعصابه وصحته ونفسيته. هو مسؤول أمام الدولة، وأمام المواطن، وأمام ضميره المهني، لكنه في أغلب الأحيان يظلّ وحيداً في مواجهة القرارات المرتجلة، والضغط المتواصل، والمحاسبة الانتقائية. لا سند نفسي، ولا مرافقة إدارية، ولا حماية من التعسّف، وكأنّ الإنهاك أصبح شرطاً غير معلن للاستمرار في المسؤولية.
ويزداد الوضع تعقيداً حين يُمنع المدير العام من أداء جوهر مهامه كالعمل الميداني، التواصل مع الفرق المتنقلة ، والاقتراب من الواقع الحقيقي للمؤسسة وللواقع المعيشي للمواطن التونسي.
فبدل تشجيعه على المبادرة، تُقيَّد حركته، وتُراقَب خطواته، وتُقصّ أجنحته باسم “التعليمات”. وهنا يتحوّل الإبداع إلى تهمة، والحضور إلى خطر، والنجاح إلى مصدر قلق لمن يفترض أن يدعمه. تلك هي اللحظة التي يُغتال فيها المعنى الحقيقي للمسؤولية، ويُدفع بالكفاءة نحو الاحتراق.
وفي مناخ يسوده غياب الاستقرار الحكومي وتغيّر السياسات بتغيّر الأشخاص، يصبح المدير العام الحلقة الأضعف في سلسلة القرار. فهو مطالب بتطبيق اختيارات لم يشارك في صياغتها، وبالدفاع عن قرارات قد لا يقتنع بها، وبالتأقلم السريع مع توجهات متناقضة. هذا الارتباك البنيوي لا يُنتج إدارة ناجعة، بل يُنتج إنهاكاً مزمناً، ويغذّي شعوراً دائماً بعدم الأمان الوظيفي، وهو أحد أخطر أسباب الاحتراق الوظيفي.
الأخطر من كل ذلك، أن هذا الواقع لا يُناقَش علناً، ولا يُعترف به مؤسسياً. فالاحتراق الوظيفي ما يزال يُنظر إليه كمسألة فردية، لا كظاهرة هيكلية تستوجب المعالجة. لا وجود لبرامج دعم نفسي، ولا آليات حماية من التعسّف، ولا ثقافة إدارية تعترف بأن الإنسان هو أساس الأداء الوظيفي . وكأن المطلوب من الإطار السامي أن يكون آلة إنتاج بلا مشاعر وبلا حق في الإنهاك.
ولا يمكن تجاهل الأثر العائلي والاجتماعي للاحتراق الوظيفي الذي يعيشه المدير العام. فخلف المكاتب والقرارات والتقارير، توجد عائلات دفعت هي الأخرى ثمناً باهظاً . أبناء حُرموا من حضور آبائهم وأمهاتهم، أزواج وزوجات عاشوا على هامش التوتر الدائم، واولياء حرموا من زيارات أبناءهم بحكم المسؤولية وحياة خاصة تآكلت تحت ضغط الهاتف الذي لا ينطفئ، والاجتماعات التي لا تنتهي، والاستدعاءات المستعجلة التي لا تعترف بوقت ولا بحدود زمني. لقد أصبح العمل يزاحم الحياة، بل يلتهمها، في صمت مؤلم.
إن المدير العام لا يملك الحق في الرفاهية وهومطالب بالنتائج، ويُحاسَب على الإخفاقات، بينما تُسحب منه أدوات النجاح واحدة تلو الأخرى. وعندما يختار الالتزام بالقانون، والحرص على المال العام، واحترام الضمير المهني، قد يجد نفسه معزولاً، مستهدفاً، أو مُعاقَباً بطرق غير مباشرة من تجميد وتهميش وتشويه، أو تحميله مسؤوليات لا يملك سلطة حقيقية عليها. وهكذا تتحوّل النزاهة من قيمة إلى عبء دون ان ننسى الرسائل المجهولة الهوية التى أصبحت في السنوات الأخيرة أداة خطيرة تُستعمل لضرب الاستقرار الإداري وكسر ظهر المديرين العامين والكفاءات النزيهة داخل المؤسسات، خاصة عندما تتحوّل من مجرّد تبليغات إلى وسيلة ممنهجة للتشويه والتصفية الإدارية. فبدل أن تكون آلية لحماية المرفق العام وكشف الفساد الحقيقي، أضحت في كثير من الأحيان سلاحًا جبانًا يُستعمل من خلف الستار لتصفية الحسابات الشخصية، أو لإزاحة مسؤول كفء لا يخضع للضغوط ولا يقبل بمنطق الولاءات.
الخطير في الأمر ليس فقط وجود هذه الرسائل، بل اعتماد بعض الهياكل الإدارية عليها دون تمحيص أو تحقيق جدي، وكأنها حقائق مطلقة، فيُبنى عليها قرار، أو تُفتح بسببها تحقيقات انتقائية، أو يُسلَّط بسببها ضغط نفسي وإداري على المسؤول المعني. وهنا يتحوّل المجهول إلى قاضٍ، وتتحوّل الإشاعة إلى أداة حكم، ويُقصى مبدأ قرينة البراءة، وهو ما يُعدّ انحرافًا خطيرًا عن أبسط قواعد العدالة الإدارية.
كما أن هذه الرسائل تُحدث آثارًا نفسية ومهنية مدمّرة؛ فهي تزرع الشك، وتُضعف الثقة، وتخلق مناخًا من الخوف داخل المؤسسات، حيث يصبح كل مسؤول عرضة للطعن في سمعته في أي لحظة، دون أن يُمنح حق الدفاع أو المواجهة. والأسوأ أن هذا المناخ يُحبط ةالكفاءات ويُشجّع الرداءة والانتهازية، لأن النزيه يُعاقَب، بينما يتقدّم من يُتقن لعبة الخفاء والوشاية.
إن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يقوم على رسائل بلا توقيع ولا مسؤولية، بل على آليات شفافة، وتحقيقات مهنية، ومحاسبة عادلة قائمة على الأدلة لا على الظنون. ولا تهدم قياداتها بالمجهول، ولا تسمح بأن تتحوّل الوشاية إلى سياسة، ولا تجعل من الرسائل المجهولة مرجعية تُكسَر بها ظهور الرجال والنساء الذين خدموا مؤسساتهم بصدق.
في النهاية، تبقى الرسائل المجهولة المهزلة عنوانًا لانحراف خطير في الممارسة الإدارية، فلا إصلاح يُبنى على المجهول، ولا دولة تُدار بالخوف، بل بالشفافية، وتحمل المسؤولية، واحترام الكفاءات وحمايتها من عبث الرسائل التي لا هوية لها ولا شرف.
إن إعادة الاعتبار للمديرين العامين تمرّ أولاً عبر تصحيح الخطاب العام، وكسر الصورة النمطية التي شيطنتهم ظلماً. وتمرّ ثانياً عبر إصلاح حقيقي لمنظومة القيادة الإدارية، يقوم على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وربط المسؤولية بالسلطة الفعلية، وتكريس ثقافة التقدير بدل ثقافة التخويف. فالإدارة لا تُدار بالضغط وحده، بل بالثقة، وبالاعتراف، وبالشعور بأن الجهد المبذول لن يضيع.
إن الدفاع عن المديرين العامين ليس دفاعاً عن أشخاص، بل دفاع عن فكرة الدولة نفسها. دولة تحترم كفاءاتها، وتحمي من يخدمها، وتكافئ العطاء بدل معاقبته. فالوظيفة العمومية ليست غنيمة، بل أمانة، ومن حمل الأمانة بصدق لا يجب أن يُكسر ولا يُهان. ردّ الاعتبار اليوم ليس مجاملة، بل ضرورة وطنية، لأن الأوطان التي لا تصون أبناءها المخلصين، تُفرغ مؤسساتها من روحها قبل أن تُفرغها من كفاءاتها. إن الوطن الذي يريد إدارة قوية، لا يمكنه أن يواصل استنزاف نخبه. والبلاد التي تطمح إلى الإصلاح، لا يجوز لها أن تحارب من يمتلكون الخبرة والقدرة والرؤية. فالاحتراق الوظيفي ليس قدراً، بل نتيجة خيارات، ويمكن وقفه متى وُجدت الإرادة السياسية والأخلاقية لذلك.
وفي الختام، يبقى السؤال مطروحاً بإلحاح كيف نطالب بالكفاءة، ونحن نُحبط الكفاءات؟ وكيف نطلب التفاني، ونحن نُعاقب المخلصين؟.