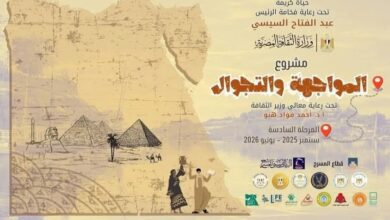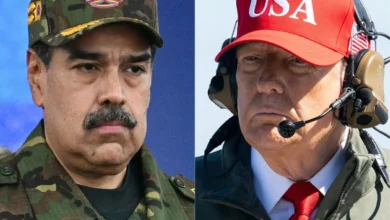بقلم: الدكتور جابر غنيميمدرس جامعي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة
ترجع كلمة حصانة من الناحية اللغوية في أصلها إلى فعل حَصُنَ، أي منع، والحصن كل
موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه، والجمع حصون. و من هنا جاءت
الحصانة immunity، بمعنى جعل المتمتع بها في حالة تمنع التعرض إليه، أو مقاضاته
لأسباب ينظمها القانون الدولي في مجال العلاقات الدولية بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي ومن
في حكمه، وينظمها القانون الوطني فيما يتعلق بمن يتمتع بالحصانة من رعايا الدول المعنية.
إن مفهوم الحصانة عموماً غير محدد، مما يجعل كل محاولة لتنظيمها في نسق واحد أمراً
صعباً، ومن ثم من غير الممكن إيجاد تعريف واحد لها، لأنه من المستحيل أن نذهب إلى
المبدأ نفسه لشرح حصانة أعضاء المجالس النيابية وحصانة رئيس الدولة والمبعوث
الدبلوماسي، أو حصانة أعضاء السلطة القضائية.
وعرفت الحصانة في القانون الدولي كما يلي: «الحصانة تعني امتياز الإعفاء من ممارسة
الولاية القضائية، أو هيمنة السلطات المحلية».
وعرف معجم المصطلحات الاجتماعية الحصانة عموماً بأنها: «إعفاء الأفراد من التزام أو
مسؤولية، كإعفائهم من تطبيق القواعد العامة في المسائل القضائية أو المالية».
وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف الحصانة عموماً بأنها: «قواعد مانعة، تضيق أو تحد من
الاختصاص القضائي للدولة». والحصانة بمعناها العام هي حماية أشخاص معينين من
الملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها في معرض قيامهم بأعمالهم الرسمية، وهي
مقررة من أجل المصلحة العامة، لا من أجل مصالح الأشخاص الذين يتمتعون بها.
إن أداء رسالة القضاء في إعلاء كلمة القانون وإقرار العدل لا يتأتى إلا باستقلال القضاء
وتقرير ضمانات حقيقية لهذا الاستقلال، و يتطلب فوق ذلك توافر صفات وفضائل معينة في
القاضي إلا أن استقلال القاضي لا يعني عدم المساءلة إذا ما أخل بواجبات وظيفته
ومقتضياتها وتقاليدها.
و قد تعـددت اتجاهـات الفقـه في تعريـف الحصـانة القضـائية بـين خلـط وتضـييق وتوسـيع ،
كمـا وردت أحكامها في قوانين مختلفة تبعا لتنوع جهات القضاء، حيث تفرد بعض الفقه
و ادعى شبهة الإجماع على تعريف الحصانة القضائية بأنها تعني مبدأ عدم قـابليتهم للعـزل ،
وقـد خلـط هـذا التعريـف بـين الحصـانة القضـائية في قـانون الإجـراءات الجزائيـة ومبـدأ
عـدم قابليـة القاضـي للعـزل، وإن اشـتركا في كونهما ضمانة من ضمانات القضاة، إلا أن
تباينهما واضح و جلي، فالحصانة قيـد قـانوني مؤقـت يحـول دون تحريـك الـدعوى
العموميـة إلا بعـد الحصـول على إذن ، أما مبدأ عدم القابلية للعزل فيعني عدم جواز فصل
القاضـي أو وقفـه عـن العمـل أو إحالتـه إلى التقاعـد أو نقلــه إلى وظيفــة غــير قضــائية إلا
في الأحــوال الــتي نــص عليهــا القــانون، و القوانين المنظمة للقضاة تفرق بين أحكام
الحصانة القضائية وهذا المبدأ و تفرد لكل منهما موادا خاصة به.
و على ذلك يمكن تعريف الحصانة القضائية بأنها حمايـة قانونيـة مقـررة لأعضـاء السـلطة
القضـائية تمنـع اتخــاذ إجــراءات التتبع ، وتحــول دون رفــع الــدعوى العموميــة علــيهم
إلا بعــد الحصــول علــى إذن.
وتكفـل جل القوانين لأعضـاء السـلطة القضـائية حصـانة تقيـد صـلاحية النيابة العمومية في
رفعـه للـدعاوى العمومية و مباشرتها ، و ليس ذلك من الامتياز الشخصي و إعطاء بعض
الأفراد أفضلية عن الآخرين، بل فرضها القانون صونا لمصالح معينة ولاعتبارات متداخلة
جديرة بالمراعاة ، فالحصانة القضائية تنطوي على توقير للسلطة القضائية ورعاية
لأعضائها حمـاة العدالـة ، ممـا يعـود أثره إلى تحقيق ثقة المتقاضين و اطمئنانهم على
دعواهم، إذ الحصانة تبقي القضاة في مـأمن مـن الادعـاءات الكيدية و تحمي إرادتهم من
الضغط و التوجيه و كل ذلك يضمن العدل و يصون الحقوق في المجتمع.
أولا : الحصانة القضائية حماية لاستقلال القضاء وصيانة لكرامة أعضائه : يعتـبر الفصـل
بـين السـلطات في الدولـة مـن المبـادئ المسـتقرة فقهـا وقانونـا ؛ لمـا فيـه مـن ضـمان
للحريـة وتأكيـد لمشـروعية الدولـة وبعـد عـن الاسـتبداد بالإضـافة إلى الميـزات الـتي
يحققهـا تقسـيم العمـل مـن إجـادة وسـرعة في الإنجـاز، فـلا يخضـع القضـاة في ممارسـتهم
لعملهـم لسـيطرة أيـة سـلطة كانـت تشـريعية أو تنفيذية ، بـل غـايتهم تحقيـق الحـق والعـدل
خاضـعين للقـانون ولضـمائرهم فحسـب ، ومسـتقلين عـن أي جهة ، فلا قضاء بغير استقلال
ولا عدل بغير قضاء ، فالعدالة قرينة استقلال القضاء دائما.
والحصـانة القضـائية تـدعم هـذا الاسـتقلال، وتـوفر التـوقير الـلازم لأعضـاء هـذه السـلطة
ممـا يحفـظ هيبتهم وكرامتهم من الاعتداء عليها، فـلا يسـتطيع القاضـي بغـير هـذه الحصـانة
أن يعلـي كلمـة القـانون في مواجهة الدولة و المجتمع ليحق الحق و يحمي العدالة.
كمـا أن في حمايـة القضـاة احترامـا للسـلطة الـتي ينتمـون لهـا وصـيانة لكرامتهـا وضـمانا
لهيبتهـا نظرا لطبيعة الواجبات التي انيطت بهذه السلطة، و لأهمية دورهم في المجتمع،
فطبيعــة العمــل القضـائي ومـا يتصـف بـه مـن خطـورة وجـلال يـبرر تمييـز القضـاة عـن
غـيرهم مـن مـوظفي الدولـة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الجزائيـة الـتي قـد تتخـذ ضـدهم ،
وقـد قيـل بحـق أنـه كلمـا ارتقـت الأمـة في نظـام الحكـم كانت الضمانات القضائية عندها
كافية وإلى الكمال أقرب.
ثانيا : الحصانة القضائية ضمان للعدل و الحق و الحرية للمتقاضين و المجتمع: إن هـذه
الحصـانة بجانـب غيرهـا مـن الضـمانات القضـائية الأخـرى مقـررة للحفـاظ علـى اسـتقلال
القاضي وصون كرامته ، وذلك بدوره يشيع في صـدور المتقاضـين الثقـة والطمأنينـة ، إذ
تبعـد هـذه الحصـانة القضـاة عـن الأهـواء والمـؤثرات عنـد فصـلهم في الـدعاوى ، حيـث
يكـون القضـاة مطمئنـين علـى مراكـزهم خاصــة في الــدعاوى الــتي تتعلــق بأعمــال
الحكومــة أو أصــحاب النفــوذ في الدولــة ، فالمســاس بــأمن القاضــي عرقلــة لأدائــه
وظيفتــه مما ينعكس أثره على استقرار المجتمع و امن أفراده تحقيقا للمصلحة العامة، فهـي
في حقيقتهــا ضــمان لحقوق المجتمع و حرية الأشخاص فيه ، لان تحقيق العدالة و توفير
القضاء النزيه غاية المجتمع و حماية لمصالحه الأساسية.
ثالثا : تفادي الادعاءات الكيدية : تحمي الحصانة رجـال القضـاء مـن الادعـاءات الكيديـة
الـتي تعـوق حسـن سـير عملهـم فيتمكن القاضي من ممارسة عمله في حرز من أي اتهام
مغرض أو قبض جائر أو دعـوى متسـرعة في غـير محلهـا ، فالقاضـي بحكـم عملـه يـوازن
بـين مصـالح متعارضـة ويفصـل في خصـومات ويثبـت الحـق لأهلـه فيرضـى عليـه خصـم
ويسـخط آخـر ، ممـا يجعلـه عرضـة للكيـد والعـداء والانتقـام ، فيتصـنع ذو الأغـراض
العدائيـة الـدعاوى والـتهم ضـد القاضـي محـاولا التشـكيك في نزاهتـه و إهانـة كرامتـه ،
طالبـا تحريـك الـدعوى العموميـة ضده والتحقيق معه ؛ لما في الإجراءات الجزائية من شدة
ومساس بالحريات قد تضـر هيبـة القضـاء وتشـفي غليل أصحاب النفوس السقيمة . لذا قطع
القـانون السـبيل علـيهم وحـرص علـى حمايـة أعضـاء السـلطة القضـائية وتأكيـد كـرامتهم ،
فتــدخل وأضــفى علــيهم حصــانة تضــيق علــى الادعــاءات الكيديــة وتحفــظ القضــاة
مــن تعســف الــبعض وانتقامهم .
رابعا: وقاية القضاة من التعسف و التأثير على قناعاتهم: فـلا تكـون إجـراءات الجزائيـة
سـبيلا لتهديد القضاة أو طريقة لضغط سلطات التحقيق على إراداتهم، فينأى القضاة بأنفسهم
عن الأهواء و المؤثرات ، وذلك مما يكفل حياد القضاء ونزاهته. إذ بالحصـانة يقـيم القاضـي
ميـزان العدالـة والإنصـاف دون رهبـة أو ميـل أو انحـراف ، فيكـوّن عقيدته وفقا للقانون
بكل حرية ودون ضغط أو إجبار يؤثر على إرادته .
و لقد نصت المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم
المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 أوت إلى 6
ديسمبر 1985، و التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم
المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 نوفمبر 1985 و 40/14 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985
” ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما
يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون
إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة،
وفقا للقانون الوطني”.
كما نصت المادة 15 من الاتفاق بشان امتيازات المحكمة الجنائية الدولية و حصاناتها “
يتمتع القضاة و المدعي العام و نواب المدعي العام و المسجل عند مباشرتهم أعمال المحكمة
أو فيما يتعلق بهذه الأعمال بالامتيازات و الحصانات الممنوحة لرؤساء البعثات الديبلوماسية.
و يواصلون بعد انتهاء مدة ولايتهم التمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع
فيمن يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية”.
و قد نصت اغلب الدول في قوانينها على الحصانة القضائية من بينها مصر و الأردن
و الكويت و المملكة العربية السعودية و لبنان و الإمارات العربية المتحدة و قطر و فرنسا
و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية…….
وخص المشرع التونسي القضاة بامتياز عند اقترافهم جرماً خارجاً عن الوظيفة أو منبثقاً
عنها، وأضفى عليه حصانة خاصة تميزهم من غيرهم، حيث نص الفصل 22 من القانون
عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى
للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على انه ” لا يمكن بدون إذن من المجلس الأعلى للقضاء
تتبّع أي قاض من أجل جناية أو جنحة أو سجنه لكن في صورة التلبّس بالجريمة يجوز إلقاء
القبض عليه فيعلم عندئذ المجلس الأعلى للقضاء فورا”.
كما نص الفصل 104 من الدستور التونسي على ” يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا
يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام
مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة”.
و الحصانة القضائية تستوجب دراسة نطاق الحصانة القضائية من حيث الأشخاص
والجرائم والإجراءات ( المبحث الأول) و نطاق الحصانة القضائية من حيث المكان
و الزمان ( المبحث الثاني)
المبحث الأول: نطاق الحصانة القضائية من حيث الأشخاص والجرائم والإجراءات
لقد حدد القانون إطـارا شخصـيا وموضـوعيا ( الفقرة الأولى) وإجرائيـا ( الفقرة الثانية) لهـذه
الحصـانة.
الفقرة الأولى: نطاق الحصانة القضائية الشخصية و الموضوعية
- الحصانة القضائية من حيث الأشخاص: يتمتع بالحصانة القضائية جميع القضاة من
الصنف العدلي سواء القضاة الجالسين أو أعضاء النيابة العمومية أو قضاة التحقيق. كما
يتمتع بها القضاة من الصنف الإداري و القضاة من الصنف المالي، بلا استثناء على اختلاف
المحاكم التي يعملون بها و على تباين درجاتهم.
ولا تمتــد الحصــانة إلى أي فــرد مــن أفــراد أســرة القاضــي، إذ هــي متعلقــة بشخصــه
فقــط فــلا تستفيد منها زوجته ولا أولاده .و لا تشمل الحصانة كتبة المحاكم. - الحصانة القضائية من حيث الجرائم: تمتد الحصانة القضـائية إلى الجـرائم المتعلقـة
بالوظيفة كالرشوة مثلا و غير المتعلقة بها كالسرقة مثلا حيث لم يقصرها المشرع على نوع
معين منها لتوافر علة فرض الحصانة في الحالتين.
لقد نص الفصل 22 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق
بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على انه ” لا يمكن
بدون إذن من المجلس الأعلى للقضاء تتبّع أي قاض من أجل جناية أو جنحة أو سجنه لكن
في صورة التلبّس بالجريمة يجوز إلقاء القبض عليه فيعلم عندئذ المجلس الأعلى للقضاء
فورا”.
و نستشف من ذلك أن الحصانة القضائية حسب القانون المذكور لا تتعلق إلا بالجنايات
و الجنح فقط دون المخالفات، و هو ما اقره كذلك المشرع المصري، على خلاف المشرع
الجزائري و العماني و الإماراتي الذين بسـطوا الحصـانة القضـائية علـى جميـع أنـواع
الجـرائم سـواء أكـان وصـفها جنايـة أو جنحة أو مخالفة.
ويـرى جانـب مـن الفقـه أنه مـن المستحسـن أن تشـمل الحصـانة القضـائية المخالفـات
أيضـا، لأن القـانون الجـزائي يعاقـب علـى المخالفـات بعقوبـة السـجن مـدة لا تقـل عـن
أربـع وعشـرين سـاعة ولا تزيـد عــن ستة عشرة يوما ، وبالغرامــة الــتي لا تزيــد عــن
ستين دينارا أو بأحــدهما ، ومــن شــأن إيقــاع هــذه العقوبـات علـى القضـاة التقليـل مـن
كـرامتهم ووقـارهم ، فيكـون القاضـي عرضـة للخـوف والتهديـد مـن تحرير مخالفات كيدية
مما قد يؤثر على حياده . لذا كان من الحسن مد هذه الحصـانة حـتى المخالفـات أسوة
بأعضاء مجلس نواب الشعب اذ تحوي حصاناتهم جميع انواع الجرائم.
لكن نلاحظ الفصل 104 من الدستور التونسي المؤرخ في 27 جانفي 2014 نص على
” يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة
التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في
مطلب رفع الحصانة”.
و نحن نعتقد أن عبارة “يتمتع القاضي بحصانة جزائية” وردت مطلقة و هو من يعني أن
الحصانة القضائية تشمل جميع الجرائم بما في ذلك الجنايات و الجنح و المخالفات، فـلا
يجــوز تخصيصـها بغـير مخصـص قــانوني أو تضـييقها بـلا مقتضـى ، كمــا أن دواعي
إحاطة القاضي بسور من الحماية من مقتضيات تحقيق العدالة بـين المتقاضـين وصـون
المصـلحة العامـة للمجتمـع . بالإضـافة إلى أن المخالفـات بـالرغم مـن تفاهتهـا –كمـا يـرى
بعـض الفقـه لا تنفي احتمالية التعسف ، بل قد يتسع مجـال الكيـد فيهـا تبعـا لبسـاطتها
وسـهولة توقيـع عقوبتهـا ، ولا يخفى ما في الإجراءات الناشئة عنها من مساس بكرامة
القضاء .
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع اللبناني يفرق بين إجراءات نزع الحصانة إذا ارتكب
القاضي جريمة منبثقة عن وظيفته و بين إجراءات نزعها إذا ارتكب جريمة غير متعلقة بها،
فالجرائم المتعلقة بالوظيفة هي وحدها التي يتوقف تحريك الدعوى العمومية فيها على إذن
وزير العدل.
الفقرة الثانية: نطاق الحصانة القضائية من حيث الإجراءات
ينص الفصل 104 من الدستور التونسي على ” يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا
يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه… وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام
مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة”.
و قد نص الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل
2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ” يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة
الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب
الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام
الأنظمة الأساسية للقضاة”.
ففـي غـير حـالات التلـبس بالجريمـة يمنـع تتبع القاضـي إلا بعـد الحصـول علـى إذن من
مجلس القضاء العدلي . والحـال ذاتـه بالنسـبة لإجـراءات التحقيـق و رفـع الـدعوى.
وتقتصـر الحصـانة القضـائية هنـا علـى الإجـراءات الجزائيـة ، فـلا تمنـع إقامـة الـدعوى
المدنيـة أمـام القضاء المدني ضد العضو لمطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على
الجريمة.
وأجـاز المشـرع التونسي في حـالات التلـبس فقـط إيقاف القاضـي بشـرط إعلام مجلـس
القضاء الراجع له بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة. و للمجلس إما رفع الحصانة
و بالتالي استمرار إيقافه أو رفضها و بالتالي الإفراج عنه من الإيقاف.
و لقد نص الفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية على ما يلي: “تكون الجناية أو الجنحة
متلبسا بها :
أولا: إذا كانت مباشرة الفعل في الحال أو قريبة من الحال.
ثانيا: إذا طارد الجمهور ذا الشبهة صائحا وراءه أو وجد هذا الأخير حاملا لأمتعة أو وجدت
به آثار أو علامات تدل على احتمال إدانته، بشرط وقوع ذلك في زمن قريب جدا من زمن
وقوع الفعلة.
وتشبه الجناية أو الجنحة المتلبس بها كل جناية أو جنحة اقترفت بمحل سكنى استنجد صاحبه
بأحد مأموري الضابطة العدلية لمعاينتها ولو لم يحصل ارتكابها في الظروف المبينة بالفقرة
السابقة”.
و يحاكم القاضي أمام المحاكم الجزائية العادية، وقـد اتجهـت بعـض التشـريعات العربيـة إلى
محاكمة القاضي أمام محاكم خاصة ، كالتشـريع الإمـاراتي حيـث أعطـى قـانون السـلطة (1(
القضائية الاتحادي بدولة الإمـارات العربيـة المتحـدة صـلاحية تحديـد المحكمـة المختصـة
بـالجرائم الـتي يرتكبهـا القضاة والتي لا تتعلق بوظيفتهم إلى الهيئة التي يؤلف منها مجلس
التأديب ، ويكـون ذلـك بنـاء علـى طلـب النائـب العـام . أمـا الجـرائم المتعلقـة بـوظيفتهم
فتخـتص الـدائرة الجنائيـة في المحكمـة الاتحاديـة العليـا بالفصـل فيه.
وكذلك أستثنى المشرع المصري محاكمـة القضـاة مـن قواعـد الاختصـاص العامـة ،
فمجلـس القضـاء الأعلى يعين المحكمة التي تفصل في جرائم القضاة ولو كانت غير متعلقة
بوظائفهم.
وفي لبنـان تنظـر محكمـة التمييـز جـرائم القضـاة الناشـئة عـن الوظيفـة أو الخارجـة عنهـا
إذا كانـت منسـوبة إلى أحـد رؤسـاء الاسـتئناف أو أحـد المـدعين العـامين لـدى محكمـة
الاسـتئناف أو إلى أحـد قضـاة محكمة التمييز أو أحد قضاة النيابة العامة ، وأما ما عداهم
فيرجع لمحكمة الاستئناف أمر محاكمتهم.
المبحث الثاني: نطاق الحصانة القضائية من حيث المكان و الزمان
لا ريـب إن الحصـانة القضـائية المفروضـة لأعضـاء السـلطة القضـائية ومـن في حكمهـم
غـير مطلقـة بــل محــددة بــأطر شخصــية وموضــوعية وإجرائيــة كمــا بينــا في مبحثنــا
الســابق، بالإضــافة إلى نطــاق مكـاني الـذي تسـري فيـه ( الفقرة الأولى) وآخـر زمـاني
لبـدايتها ومنتهاهـا ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: نطاق الحصانة من حيث المكان
لم يقصـر القـانون التونسي سـريان الحصـانة القضـائية علـى جـزء معـين مـن محـيط الدولـة
التونسية، وعليـه يتمتـع القاضـي بها دون تحديد لمكان معين داخل حدود الدولة فتمتد لجميع
أقاليم الدولة أي إقليمها البري و إقليمها البحري و إقليمها الجوي.
و لا يتمتع القاضي بحصانة خارج الدولة التونسية.
و تجدر الإشارة إلى انه في بعض الدولة العربية مثل مصر و الكويت مثلا تمــنح القاضــي
–فــور تعيينــه- جــوازا دبلوماســيا يــوفر لــه حمايــة مــن التعســف ويحــول دون اتخــاذ
الإجراءات الجزائية ضده خارج دولته إلا بإذن من بلاده ، ومـن مـبررات ذلـك –كمـا
نعتقـد- إن القاضـي يمثل دولته بانتمائه لسلطة أساسية فيها يجب حفظ هيبتها وكرامتها أينمـا
حـل صـاحبها .
والقاضـي –وإن لم يكن في منأى عن الزلل إلا أن امتهانه أو التنقيص من شانه إنما هو تهجم
على الدولة و تقويض لإحدى سلطاتها الرئيسية حامية للعدل و كافلة للحقوق، كما انه في
الخارج عرضة للكيد خاصة في الدعاوى ذات الصبغة الدولية التي نظرها .
الفقرة الثانية: نطاق الحصانة القضائية من حيث الزمان
أولا: بدء سريان الحصانة القضائية :كـاد يسـتقر الفقـه على أن الحصانة القضائية يتمتع بها
أعضاء السلطة القضائية عند حملهم صفة قاض ، وتسـتمر معهـم أثنـاء شـغلهم منصـب
القضـاء .
ويظهـر لنـا مـن ذلـك أن الحصـانة القضـائية تبـدأ بتـولي منصـب القضـاء (التعيـين)
وتسـتمر مـع القاضـي طالما كان شـاغلا لهـذا المنصـب، ونـرى أن الحصـانة فرضـت
لحمايـة السـلطة الـتي ينتمـي لهـا القاضـي ولـيس صيانة لشخصه.
ثانيا : زوال الحصانة القضائية :اختلـف الفقـه في تحديد وقت انتهاء أحكـام الحصـانة
القضـائية فـيرى أغلـب الفقهـاء زوالهـا بانتهـاء خدمـة القاضـي، ويـذهب فريق آخر منهم
إلى بقاء الحصانة عند انتفاء صفة القاضي .
حيــث يــذهب جمهــور الفقهــاء إلى أن العــبرة بالصــفة وقــت اتخــاذ الإجــراء ، ومــؤدى
ذلــك إن الحصـانة تـدور وجـودا وعـدما مـع وصـف القاضـي مـتى مـا حمـل هـذا الوصـف
اسـتحق الحمايـة ، فيتمتـع بها القاضي بمجرد تعيينه و تستمر معه أثناء عمله في القضاء
و تزول عنه بانتهاء خدمته لأي سبب كان كالاستقالة و العزل . وحجتهم في ذلك أن المشرع
قصد بالحصانة رعاية القضـاء وتنتفـي الحاجـة لهذه الرعاية بانتهاء خدمة القاضي ، فالمعول
عليه إذًا –حسب هذا الرأي- الصفة وقـت اتخـاذ الإجـراء لا وقـت وقــوع الجريمــة ولا
وقــت التحقيــق فيهــا ، فلــو وقعـت الجريمــة قبــل اكتســاب صــفة قــاض ثم اتخــذ ثم
اتخذ الأجراء بشأنها أثناء عمله القضائي استفاد القاضي من هذه الحماية إلا انه لا يستفيد منها
لو وقعت الجريمة أثناء عمله القضائي ثم اتخذ الإجراء بعد انتهاء خدمته.
و نحن نعتقد أن الحصانة لا يتمتع بها إلا من كان يحمل صفة قاض سواء مباشر أو بحالة
إلحاق.
ختاما يمكن القول أنه إذا كان القضاء يعني العدل فهو يعني القاضي الذي يطبق و يعلي كلمة
الحق. و لتطبيق القاضي العدالة يجب توفير الحماية له و تأمينه ليعيش مطمئنا في حياته،
مستقرا في عمله، و تتمثل هذه الحماية بتوفير الضمانات التي تحفظ هيبته، و تصون كرامته،
و أهم هذه الضمانات تمتيعه بالحصانة القضائية، غير أن هذه الحصانة لا تعني ألا يطبق
القانون بحق القاضي، بل يسري عليه و على غيره، حيث إن العموم من أهم خصائص
القاعدة القانونية، و إنما المقصود أن لتطبيق القانون عليه إجراءات تضمن سلامة عمله الذي
يقوم به.